“أحسن الحديث”..و”أحاديث الرواة”..فارق مُهْوِلٌ يُبْطِل الصِّلَة!!

في المقال السابق، حين تحدثتُ عن قراءتنا الملتبسة للديني والتاريخي، وما ينتج عنها من مشكلات عويصة ذكرتُ إحداها على سبيل المثال لا الحصر، كنتُ أعني في الوقت ذاته موضوع الأحاديث المَروِية والمنسوبة إلى النبي ظلما وعدواناً، وألحّ على هذه الوصف القدحي، لأن أغلب تلك الروايات كان خادماً لأوطار أُولي الأمر من البُغاة في تلك العهود، ويُخالف منطوق القرآن الحكيم ومقاصده، ويُخالف بالتالي معيارَيْ العقل والمنطق… فالنص الديني كما نعلم جميعاً يستحيل ان يخالف هذين المعيارين الأساسيين!!
فضلا عن ذلك، فرسول الهدى يستحيل عليه ان يبلّغ أمّتَه رسالةَ ربه ثم يبدأ هو نفسه، قبل غيره، في مخالفتها أو نسخها، بمعنى الإلغاء، أو إصابتها في مقتل. و”الإصابة في المقتل” هنا مجرد مَجاز، لأن المُصابَ في حقيقة الأمر ليست الرسالة المنزلة، بل هو العقل المتلقّي، وخصوصاً عند بسطاء المسلمين. أما ذوو الألباب منهم فقد انتصبوا منذ زمن غير يسير للإلقاء بدلائهم في هذه “المعمعة”، وأنا أطمح بكل تواضع، إلى ضم صوتي إلى أصواتهم رغم ما يصلهم، ويصلني أيضا في حالات كثيرة، من السب والشتم والتمريق والتكفير… ولم يبق إلا ان يصلني عُنْفُ أحدِهم الجسديّ والملموس، بعد أن قال لي أحدُهم ذات يوم عَبْرَ اليوتيوب: “أتمنى أن ألتقي بك لأشرب من دمك”، هكذا بالحرف، فأجبته بالقول “إنني أيضا أتحرّق إلى رؤيتك رغم ما وصلني منك مُسْبَقاً من بذيء القول وكريه الرائحة”!!
الموضوع هنا، إذَنْ، شبيه كل الشبه بسابقه (المقال السابق) المتعلق بواجب التفريق بين الديني الإلهي، والتاريخي البشري، لأن التمييز بين “أحسن الحديث”، الذي هو عين كلام الله، وهو الذي وصف كلامه بهذا الاصطلاح الواضح والصريح، وبين كل الأحاديث المأخوذة عن الرواة، والتي يختلط فيها الغث بالسمين والحق بالباطل، ينبغي أن يكون مطلوباً بإلحاح، بل واجباً أكيداً على كل مَن يُشَغِّلُون عقولهم، حتى يتحقق لنا القطع مع هذا الخلط الفظيع، الذي جعل “علماءَ” أعتبرهم شخصياً “جُهَّلاً” يسقطون فيه رغم ما أحاطوا به ذواتِهم من هالات التقديس، وأضواء الشهرة، ودوائر النفوذ، ومنهم “فقهاء” أعلام من مختلف المَجامع والمراكز والمعاهد العلمية، في مختلف بلداننا المصابة بكل مكامن ومظاهر التخلف والانتكاس!!
حول مطلب التمييز هذا، قال لي ذات مناقشة هادئة صديقُ طفولة كان يشغل منصب رئيس مجلس علمي محلي، إن فقهاءنا سيردّون عليك (يقصدني) بالقول: “إن وصف رب العزة كلامه ب”أحسن الحديث”، هو الدليل على وجود “حديث” بل “أحاديث” أخرى صادرة عن غيره، ولذلك وُصِف كلامُه من لدنه بكونه أحسنَها إطلاقاً، بمثلما يدل وصفه ذاتَه ب “أحسن الخالقين” على وجود “خالقين آخرين”!!
بصراحة، لن ينطلي عليّ مثل هذا الرد الشيطاني والغبي، لأن التعبير القرآني “أحسن الحديث”، جاء هكذا بالمطلق، وبالتالي فإنه يقتضي انتفاء صفة “الحديث” وكذا طبيعته عن أي قول آخر غير كلام الحق عز وجل. لأن الأمر لا يتعلق بمجرد تسمية أو وصف، بل بمكانة ذلك الموصوف والمسمّى من العقل أو العقول المتدبرة، وعلاقته بها وفعله فيها… وهذه كلها لا يصح أن تكون لأي قول آخر غير كلام رب العزة… فكيف ذلك؟
إن القرآن كلام الله، وقوله الحق، ولكن الرسول لا يقوله ولا يتكلم به، بل “ينطق به” فحسب، فهو “الناطق” بقول الله وكلامه، اللذان ليسا لا قول ولا كلام الرسول على الإطلاق.
مِن هنا جاءت الآية في سورة النجم: “وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى” إشارة إلى “نطق” الرسول “بكلام” ربه جل وعلا، ولم يأت في الآية: وما “يقول” أو “يتكلم” عن الهوى… تماما كما هو شأن الناطق باسم رئيس دولة من دُوَلنا مثلاً، يُدلي بمواقف الرئاسة وقراراتها التي ليس له فيها أيّ يد، ولا يَسَعُه أن يزيد فيها أو ينقص منها قَيْدَ شعرة.
من هنا، يبدو الفارق شاسعاً وجلياً كشمس الظهيرة بين “أحسن الحديث” من جهة، وفي الجهة الأخرى والمقابِلة كل أشكال القول والنطق والرواية، التي لا ترقى إلى أن تحمل توصيف “الحديث”.
إننا لو كنا نُفعّل فهمنا الاصطلاحي لمعنى “الحديث” ودلالاته، التي تعني “الكلام المتجدد بلا انقطاع”، و”الثابت في تجدده كلما نطق به لسان أو لامسه عقل”، وهذا مُدرَكٌ من تَدَبُّر جذر الكلمة “حَدَثَ”، لأدركْنا أن تسمية “الحديث” لا تليق بغير كلام الله وحده دون سواه!!
إن هذا الأمر ينطبق أيضاً تمام الانطباق على اصطلاح “سُنّة”، التي تعني دَلالياً “الأمر أو الفعل المتكرر على الدوام إلى درجة الثبات في تكراره”، ولذلك لم يرد هذا الاصطلاح في الكتاب الحكيم إلا مقرونا برب العزة وليس بغيره مطلقاً: “سنّة الله”، (“لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلاً”)، ومِن ثَمّ فنسبة السُّنّة للنبي فيها بغي وجهل وتطاول، لأن غير الله يستحيل عليه أن يجسّد عادةً أو فعلاً يتحقق فيه الثبات ودوام الحال… وإنما يتحقق ذلك في سنة الله فقط لا غير!!
من هنا يكون قولنا لأفعال البشر “سُنن” متّسِماً بالكثير من البغي والتطاول، حتى لو كان أولئك البشر أنبياء أو رُسلاً، لأن أفعال هؤلاء متغيِّرة ومتبدِّلة ثم زائلة، وبالتالي ينتفي فيها المعنى الدلالي والقرآني للسنّة!!
أرجو أن يكون كلامي في هذا الموضِع مفهوماً بما فيه الكفاية، وأعتذر هنا عن البوح بهذا الرجاء، فإنني لم أقصد به التنقيص من فهم المتلقّي وإنما جاء على سبيل: “بَلَى ولكن ليطمئنّ قلبي”، لأنّي أعلم بأنني أخاطب عقولاً لبيبة وغنية بالمدارك والمعارف…
ونعود إلى ذلك التمييز المطلوب والواجب بين “أحسن الحديث” الذي هو كلام الله، وبين ما كان يصدر عن النبي، الإنسان، خارج النطق والتبليغ بآيات الرسالة، من أقوال وحركات وسكنات كانت كلها ابنةَ مجتمعها وبيئتها، وصادرةً عن طبيعة بشرية عادية وبسيطة عَبَّر عنها التنزيلُ الحكيمُ بوصفه البليغ للنبيّين بأنهم “كانو يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق” بمعنى أنهم كانوا بَشَراً بكل معنى الكلمة… والإنسان ليس له “حديث” بالمعنى القرآني لهذا الاصطلاح، كما أنه ليست له “سُنّة” بنفس المدلول المنزَّل، ولو التزم السلف بهذه الحدود الفاصلة في الفهم بين ما هو رباني إلهي، وما هو إنساني بشري، لما رأينا الآن بين صفوفنا أناساً يساوون بين “الروايات” و”أحسن الحديث” إلى درجة تفضيل الأولى على الثاني، أو وَضْعِهِما في أحسن الأحوال على قدم المساواة، بل سمعنا أنفاراً كثيرين منهم يمنحون السبق والغَلَبة للروايات على الآيات البيّنات، وكذلك فعلوا بسنة الله، التي بدأوا بمساواتها بما سموه “سنة نبوية”، فقالوا افتراءً إنها تشرح القرآن وتُفَصِّله، والله يقول “ألر كِتَابٌ أحكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ” (هود-1) قبل أن يقولوا بكل جهالة ووقاحة إنها تُكمِّله، فاتهموه بذلك بالنقصان، وقبل أن يقطع أكابرهم بأن السّنّةَ تعادل ثلاثة أرباع الدين، وأن القرآن يستأثر بالكاد برُبعه الباقي، وبأنّه لا تقوم له قائمة بغير تلك السنة البشرية، التي سمّوها نبويةً بمنتهى الضلال… فهل لدينا للخروج من هذا الغَيِّ و”لَهْوِ الحديث” من سبيل؟!!
مرة أخرى وأخيرة… علينا أن نُعطيَ لله ما لله، ولقيصر ما لقيصر، فنفصل فصلا عقلياً ومنطقياً وبالتالي موضوعياً وعلمياً بين “الديني” و”التاريخي”، ثم بين “كلام” الله و”نطق” رسوله ونبيّه… ولَعُمري، فهذا هو السبيل الوحيد لِنردّ وندفع عن أنفسنا ما يُكيله لنا الأغراب والأعاجم من السخرية والاستهجان وهم يروننا نُعيد إنتاج تجاربهم القديمة الفاشلة، التي جعلتهم يربطون الديني/الإلهي بالوضعي/البشري، ويقدسون بالتالي بَشَراً، ويؤلهون بَشَراً، رغم أننا نتلو كتابا يصدّنا عن ذلك بصريح القول، ونقرأ لنبينا الصادق الأمين قوله الناهي:
“لا تطروني كما تطري النصارى ابن مريم”!!
هل فعّلنا تلك النواهي القرآنية؟.. هل اعتبرنا بما قاله النبي من نَهْيٍ عن تدوين الحديث، وعن الانكباب على شخصه بالمدح والثناء والإطراء دون الاقتداء بأمانته وصدقه وجمال خلقه وجلال فهمه لمقاصد التنزيل الحكيم الذي أثقل كاهله فألقيناه نحن وراء ظهورنا، واتّبعنا بدلا منه “ما ألفينا عليه آباءنا”، خلافاً للتحذير القرآني المتكرّر من اتّباع الآباء بغير تقليبٍ وتمحيص، وبغير استثمار لنعمة العقل، إلى أن أدّى بنا ذلك إلى كثرة الخلاف والاختلاف، فكنا في ذلك “من المشركين، من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعاً كل حزب بما لديهم فرحون” (الروم-32)؟!!
ألم نتشبه بهؤلاء بالفكر والفهم والقول والفعل… وربما أيضاً بالمآل؟!!
نسأل الله السلامة والعافية في الدين قبل الدنيا، وفي العقول قبل الرسوم والأبدان!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي


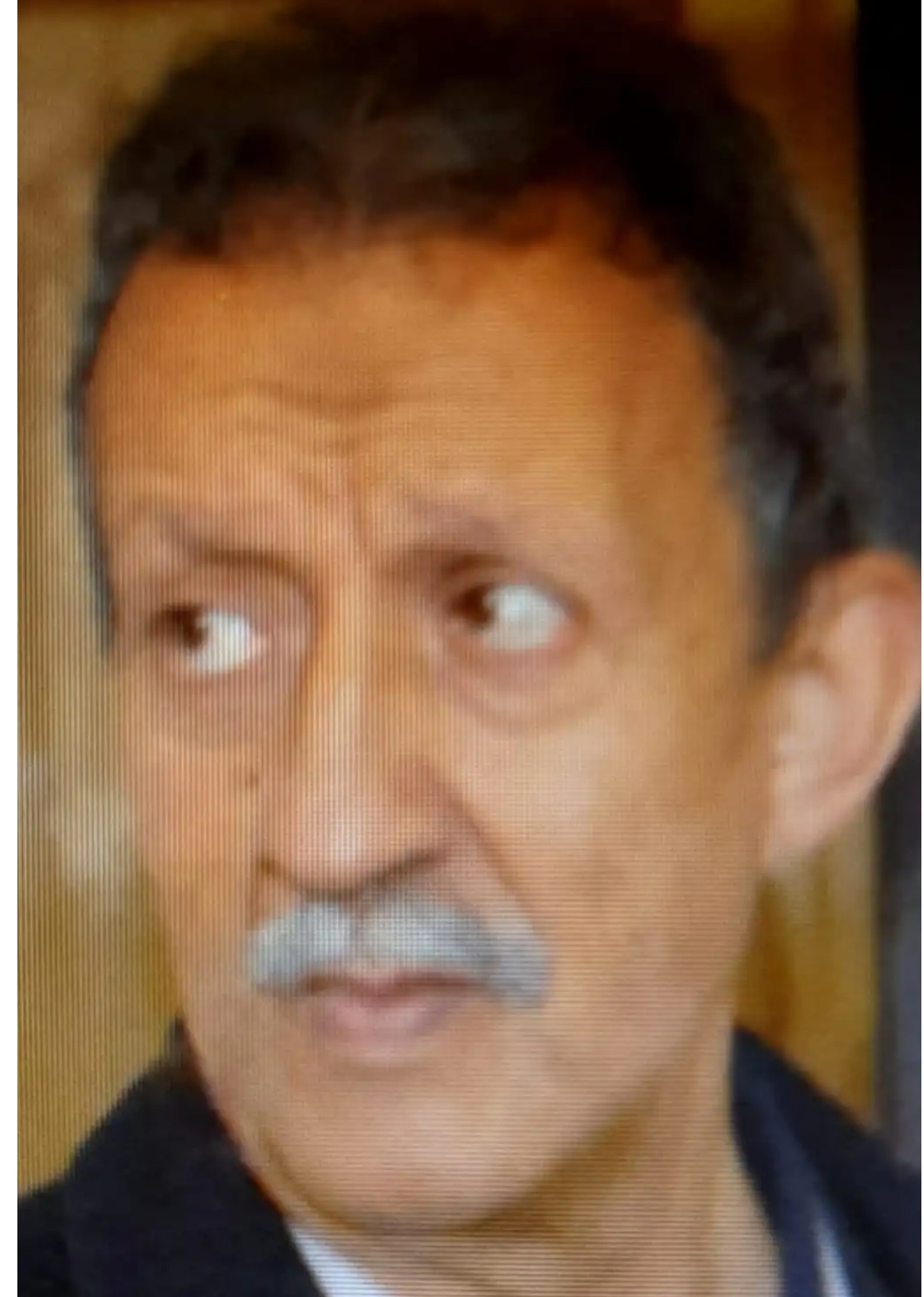


تعليقات 0