حول أزمة التواصل: كيف نوقف طوفان الرداءة؟!!

بالمناسبة، والمناسبة شرط كما يقول المناطقة، يحضرني، وأنا أشرع في مناقشة هذا الموضوع، أنّ بعض مؤسساتنا يلجأ إلى مكاتب أو مقاولات أجنبية للدراسات في مجال التواصل والعلاقات العامة، من فرنسا أو غيرها، لتقدّم خدماتها في مضمار “الكوتشيغ”، لعلها تفك شفرة التعطيل أو الضعف الذي يعاني منه مجال التواصل لدى تلك المؤسسات، وهنا يَطرَحَ سؤالٌ نفسَه بإلحاح: “كيف يلجأ هؤلاء إلى مكاتب دراسات آجنبية تَمْتَحُ معاييرَها ومصادرَها من مقومات ثقافة غير مغربية، وبالتالي، وبالبداهة، تكون عاجزةً عن فهم الطبيعة الاجتماعية والثقافية والإنسانية ثم الإدارية لمشكل التواصل في بلادنا، سواء تعلق الأمر بمؤسسة خصوصية أو عمومية”؟!
لقد سبق أن ناقشتُ هذا الأمر أكثر من مرة… بَيْدَ أن المشكل الذي أناقشه الآن يختلف عنه قلبا وقالباً، ويتعلق تحديداُ “بوسائل التواصل الاجتماعي“، وقنواته ووسائله التي صارت متاحة بين أيدي كل من هبّ ودبّ، فصار كل من يحمل هاتفا ذكياً يمارس العمل الصحافي، بل يتطاول عليه إخباراً وتحليلاً وتوثيقاً، دون أدنى معرفة بقواعد هذا النشاط الإعلامي والتثقيفي، فينتج عن هذه الظاهرة المَرَضية اختلاطٌ بين الحابل والنابل، أقصد: حابل الجهل ونابل الرداءة، فيتولّدَ عن ذلك واقعٌ يصعب القفزُ عليه أو تجاوٌزُه، لأن كَمَّ المتدخلين جدُّ مُهْوِل، وكَيْفَهم جدُّ رديء،…
النتيجة المنطقية والمتوقَّعة: أخبار زائفة وكاذبة، وتحليلات تثير الغثيان، والأدهى من ذلك، ظهور وجوه غير صالحة لأن تظهر أساساً وهي تملأ نصف شاشات العرض أو أكثر، تاركةً كُوَّةً صغيرة لعرض موادها وموضوعاتها، وكأن هؤلاء يعتقدون أننا نقتات من وجوههم…
ويبقى أقبح هذه النماذج ذلك الهارب إلى خارج الوطن من جراء متابعات وأحكام قضائية، صادرة في حقه من أجل ارتكابه جُنَحاً ثقيلة، ولكنه بدلاً من ارتداء “طاقية الإخفاء” والعيش في سلام، يصر على الإطلال علينا بين سويعات وأخرى ليَسُبَّ هذا، ويَفضح ذاك الآخَر، ولِيُشَهِّر بهذه المواطِنة أو تلك، دون أن يُلْقِيَ أيَّ بالٍ أو اعتبارٍ لِما يُسببه ذلك من الأذى لمواطنين من مختلف الفئات لم يسلموا بالجملة من هجماته المجّانية، حتى أنه يبدو كما لو كان ينتقم لنفسه من أهل بيته…
الحال أن هذه النماذج من الرداءة يصعُبُ عدُّها وإحصاؤُها في هذا الباب، وإنّ المرء ليحتار فيما ينبغي التوصيةُ به، هل يوصي بإقفال شبكات التواصل “اللاّاجتماعي” فينضرّ من ذلك مواطنون مُسالمون، وطلبةٌ باحثون، وزوارٌ مُبحرون بغرض التسلية والترويح عن النفس؟!
أَمْ هل يجب على المرء أن يُقيم دعاوي قضائية ضد القنوات سالفة الإشارة، أو ضد أصحابها، من أجل ارتكابهم جُنَحَ تلويثِ الذوق العام، وإفسادِ تربية “صِغار الزوار”، الذين لا يزالون في طور التنشئة والتّعَلُّم؟!؛
أَمْ أنّ على المرء أن يُنشئ هو الآخر قناةً أو أكثر ويَقضي سحابةَ أيامه في الرد على هؤلاء وتبخيسهم وفضحهم أمام الملأ الإفتراضي… أم ماذا؟!
من لديه جوابٌ شافٍ على هذه الأسئلة الحائرة فليتفضل وله على ذلك أجْزَلُ الشُّكرٍ وأَعظمُ الثَوَاب!!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي


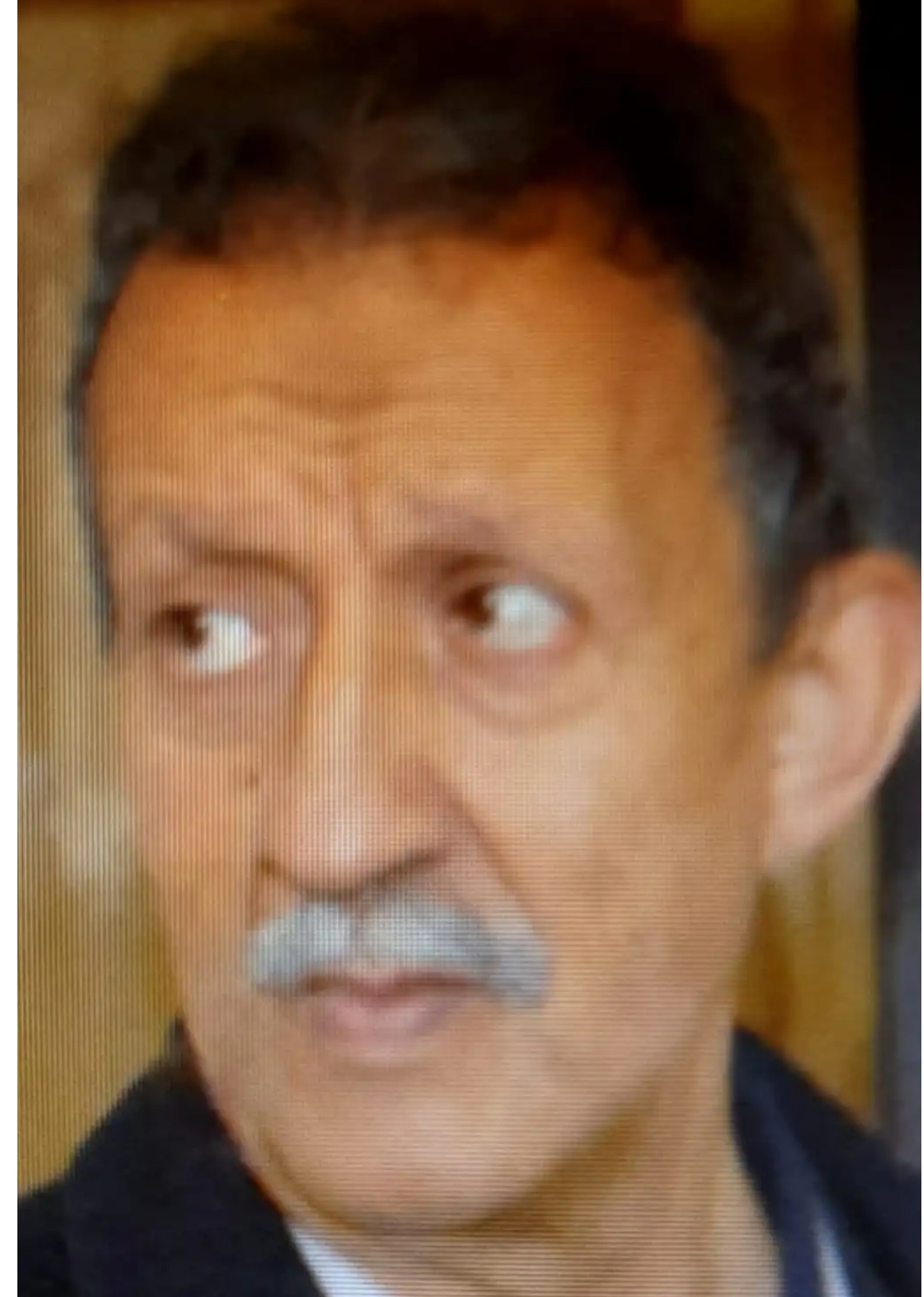


تعليقات 0