مرة أخرى: جدلية “الثابت” و”المتغير”!!

بدايةً، ينبغي الاتفاق على حقيقة خالصة يدعمها المنطق والبداهة، وقبل ذلك يزكّيها التنزيل الحكيم، وهي أن “الثابت” ينبغي أن يكون أزلياً في أوّله بحيث لا تكون له بداية، لأنه هو عينُه الأولُ والبدايةُ غيرُ المسبوقة، فلا يأتي قبله بالمطلق أيّ وجود أو موجود… ويكون كذلك سرمدياً في “لانهايته”، إذ هو بالمطلق بلا نهاية، لأنه هو نفسه الآخِر والنهاية.
من هنا ينبغي بالتالي أن نتّفق على كون هذا “الثبات”، بهذا المعنى والمفهوم الواضحيْن، يستحيل أن يتحقق سوى لله الواحد الأحد، في تفرّده وإطلاقه ووحدانيته.
بتحصيل هذا الحاصل، يكون كلام الله “ثابتاً”، وكذلك أحكامُه وأوامرُه النابعة من مطلق علمه وخبرته ومشيئته، فهو يعلم ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وبالتالي فكلامه أو أمره أو حكمه ثابت ومطلق ومنزّه عن الزمان والمكان، وهذا ينفي نفياً مطلقاً “مقولة الناسخ والمنسوخ”، التي ارتكبها وما زال يرتكبها “فقهاء” لا أعلم شخصيا من أين جاءهم الفقه، و”علماءٌ” لا أدري أين تصيّدوا وصف العلمية، و”شيوخٌ” ليس لهم من المشيخة سوى حروف هذا اللقب!!
أمّا “المتغيِّر” فهو، بخلاف ذلك، كل ما دون الله “الثابت” وكلامه وحكمه وأمره بلا أدنى استثناء، كائناً كان، أو نيّةً أو فهماً أو قولاً أو فعلاً… وكيفما كان مصدرُه ومرجعياتُه.
وبمناسبة ذكر المصدر والمرجعية، فحتى لو كان القرآنُ، وهو كلام الله “الثابتُ”، مصدراً ومرجعيةً لأي فكر أو قول أو فعل، من خارج القرآن ذاته، فإنه لا يكتسي صفة الثبات لأنه يبقى إنسانياً لا أقلّ ولا أكثر، حتى لو صدر عن نبي أو رسول!!
ينجم عن هذا الفارق، الأساسي والمبدئي، أن كل ما هو دون اللهِ وكلامِه وأوامرِه وأحكامِه ينبغي أن يكون خاضعاً لسُنّة “التغيير”، وهي السُّنّة التي تقتضي الجعل والتحوّل في الذات، وبهذا تتحقق “الجدلية الداخلية” التي تنتج عنها السيرورة والصيرورة في الأحوال والمقامات؛ وتتولد عنه أيضاً “الجدلية الخارجية”، التي تقع بالوجوب خارج الذات، فينشأ عنها تَطَوُّرُ الصِّلَةِ داخل المجتمع فيما بين مُكَوِّناته، ثم تَطَوُّرُ علاقاته مع غيره من المجتمعات!!
إن هذا يحيلنا على حكم منطقي، وبديهي، يقتضي أن يكون كلام الله ثابت لا يحتمل التغيير ولا التبديل، ولذلك جاء في الآية 115 من سورة الأنعام: “وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”؛ والآية 29 من سورة ق: “مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ”.
إن هذا الحكمَ داتَه يستوجب بالمقابل أن يكون كل ما هو “من عند غير الله” مُتبدِّلاً ومُتحوِّلاً ومُتطوِّراً بالوجوب، ويكون بالتالي مَثاراً للخلاف والاختلاف (“أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا”/ النساء – 82) ثم زائلاً وتاركاً مكانَه لغيره من مستجدّات الفهم والقول والفعل!!
يَنتُج عن هذا، بالبداهة، أن القول “بثبات” أي كلام أو فهم أو فعل بشري سيُفضي منطقياً إلى الشرك “مع الله”، لأن القائل بهذا يُشرك بشراً “مع الله” في خاصية “الثبات”، التي لا تجب سوى لله وكلامه وأمره وحُكمه كما سلف القول.
أما إذا لجأ هذا القائل إلى الجبر والإكراه لفرض قناعاتِه باسم الله ودينه القيّم، فسيكون بذلك مشرِكاً “بالله”، وليس فقط “مع الله”، وهذا أعظم وأفظع، لأنه تطاول على مناطٍ إلهيّ لا ينبغي لغير رب العزة، فاستعمل اسمَ الله أو دينَه لممارسة القهر والقسر اللذين يتطوران، في حالات كثيرة، إلى العنف الجسدي، وبالتالي إلى “تَعَدٍّ صارخٍ لحدود الله”، بكلّ معنى التعدّي ومفهومِه السائدَيْن لدينا عن “الإرهاب”!!
الآن، يمكننا أن نفهم كيف أن الله جل وعلا أمر في تنزيله الحكيم بقتال “المشركين” أينما حلوا وارتحلوا، وبقتلِهم أينما ثُقِفوا، لكونهم في حقيقة أمرهم “إرهابيين” بكل المعايير… والعالم برمّته، بكل مجتمعاته وأُمَمِه ودُوَلِه وأنظِمَتِه ومِلَلِه ومُعتقداتِه، يحارب هؤلاء ويكسر شوكاتهم في كل الأزمنة والأمكنة بلا أدنى استثناء، لأن ذلك كان ولا يزال قيمةً ومبدأً كونيَّيْن لا يختلف حولهما اثنان، وإنما جاء التزيل الحكيم ليؤكّد عليهما ويجعل منهما تكليفاً ملقىً على عاتق كل إنسان قادر على حَملِه وتَحَمُّل تبِعاتِه…
انطلاقاً من هذا الفهم، لا مجال إذَنْ لأنْ يُزايِد علينا أحد من “الكهنوت الديني” أو من “عُبّاد التراث” باعتماد تفاسير السلف، التي عرّفت المشركين بكونهم يعبدون “مع الله” آلهة أخرى، وهذا تفسير باطل، لأن حقيقة هذا الوصف أنّ الموصوفين به ليسوا مشركين “بالله”، وإنما هم مشركون “مع الله”، وهذا نوع أدنى من الشرك يستوجب التوبةَ والرجوعَ عنه ومحوَه بصالح الأعمال وليس أكثر.
ونعود بعد هذا البيان إلى “جدلية الثابت والمتغيِّر”، لنفهم كيف أن “العلماء” و”الفقهاء” و”الشيوخ” الذين يتعصّبون لفهمهم ورأيهم ويزايِدون بهما على غيرهم، ثم يُفتون باستعمال العنف لفرض ذلك على الأغيار، هم من منظور ما سبق تبيانه من المفاهيم مشركون “بالله”، لأنهم “بالله ودينه” يحاولون قمع غيرهم وإجباره على اعتناق نمطهم من الفهم والرأي والقناعة!!
نعم… أعرف ما أقوله وأدرك تمام الإدراك ما ينجم عن هذا القول من مفاهيم انقلابية، ولكن انقلابها ليس في حد ذاتها، لكونها في حقيقتها مفاهيمَ أصيلةً ومتأصّلةً، وإنما هي منقلبة عند مقابلتها ومواجهتها بمفاهيم سلفية أعتقد بكل تواضع أن الأوان قد آن لوضعها على طاولة التشريح، من أجل تعرية ما تُخفيه تحت أرديتها الطقوسية والتعبّدية من أباطيل استطاعت على مدى ثلاثة عشر قرناً، ويزيد، أن تدفع بمئات الملايين من المسلمين المؤمنين إلى درك الضلالة والضياع الفكري والعقدي!!
والواقع أن أحوال هذه الأمة تُغني عن مزيد إطناب، وكذلك سَيْلُ الإساءاتِ والاتّهامات القَيْمِيةِ التي يُعامَل بها الإسلامُ ذاتُه ويُلحَقُ النصيبُ الأعظم منها بالمسلمين، والإسلام والمسلمون الحقيقيون منها براء!!
إن هناك كثيراً من الأمثلة على صواب ما ذهبنا إليه أعلاه، من التمييز الصريح بين “الثابت” و”المتغيِّر”، حتى أن نبي الرحمة أكد ذلك وكرّسه بما قدّمه لنا من القدوة والأسوة الحسنة، فمنع تدوين أحاديثه حتى لا تتحول إلى “ثوابت” فتختلط على الناس مع الوحي المنزّل، وحظر على نفسه الكريمة تفسير القرآن حتى لا تتحول تفاسيره إلى “قرآن جديد” مُنافِس ومُزاحِم، لِعِلمه بأن قومَه قد يسقطون في فخ تقديسه كما فعل النصارى بعيسى ابن مريم، فيُقدِّسوا بذلك كلامَه وتفاسيرَه، فيصبح الوحي المنزل عليه أكثر هجراناً من لدن قومه، ليس كُفراً ومروقاً، وإنما من حيث سيعتقدون “بثبات” أحاديثه وتفاسيره فيشركونها في صفة “الثبات” مع كلام الله عز وجل، وهنا مبعث الضلال المُبين!!
المصيبة أن علماءَنا وفقهاءَنا وشُيوخَنا فعلوا ذلك بالملموس مع الحديث والسُّنّة، رغم فبركتهما بعد وفاته بنحو قرنين، فما بالُنا لو كان هو ذاته قد ترك كل ذلك مُدَوَّناً ومُوَثَّقاً بتدبير مباشر منه أو بخط يده، عليه أزكى السلام؟!!
نعم… لقد بلغ التطرف في هذا المنحى درجات صار فيها البعض أقرب إلى تأليه النبي الكريم، حتى امتلأت دعوات البعض، وهم السواد الأعظم، بالتحفيز على تمجيد الذات النبوية إلى درجة تقديس بُصاق النبي، ونُخامه، وعَرقِه، ونِعالِه، وخصلات شعره (!!!) مُسبغين عليه بذلك صفات “فوق بشرية” لا يقبلها العقل ولا المنطق… وهذا قد تناولته في مقالات سابقة ولكنْ، لا حياة لمن تنادي!!
بالمناسبة، ومن باب ضرب المثل، وقع لي ذات مناقشة هادئة خصامٌ صامت، ولكنه شديد الحِدَّة، بيني وبين ابن صديق لي، وكان الخصام من لدنه هو، لأنني لم أقبل ادعاءه بأن جثمان النبي الكريم لم يتحلل، وان الله حرّم على الأرض ودوابها الدقيقة من دود وحشرات وطفيليات وبكتريا وجراثيم أن تلمس جسده الطاهر… وخاصمني وقاطعني لأنني استدللتُ من القرآن على أنه كما وصفه رب العزة “بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق”، بمعنى انه يسري عليه كل ما يسري على البشر بلا أدنى تمييز، وأن هذا بالذات لا يُنقِص من قيمته بل يُعلي من شأنه، لأنه رغم طبيعته البشرية أدى رسالة يستحيل أن تحملها الجبال الشوامخ والراسيات… ذلك، أنّ الواقع الذي لا يُعلَى عليه، هو أنّ هذا الإنجاز، المبهر والباقي على مدار العصور، تحقق على يد رجل بدوي متّسم بالبساطة والعفوية في جميع جوانب حياته ومعاشه، وفي كل حركاته وسكناته!!
اعتقد أن “علماءنا” و”فقهاءنا” و”شيوخنا” هم على نفس الدرجة من التعصب لهذا الموقف غير المنطقي ولا العقلاني ولا العلمي، ولا حتى الإنساني الطبيعي والفطري… لأنهم انساقوا بإفراط شديد في إسباغ نوع من القدسية لا يليق إلا بالحق جلّ جلالُه، وهذا ليس تنقيصاً من شأن الصادق الأمين ومَنزلتِه، بقدر ما هو إرجاع لجَوَامحِ الفكر والاعتقاد والتباسات الفهم والإدراك إلى سكة العلم والمنطق…
نسأل الله في فهمنا وتَدَيُّنِنا السلامةَ والسدادَ والعافية!!!
بقلم ذ. عبد الحميد اليوسفي


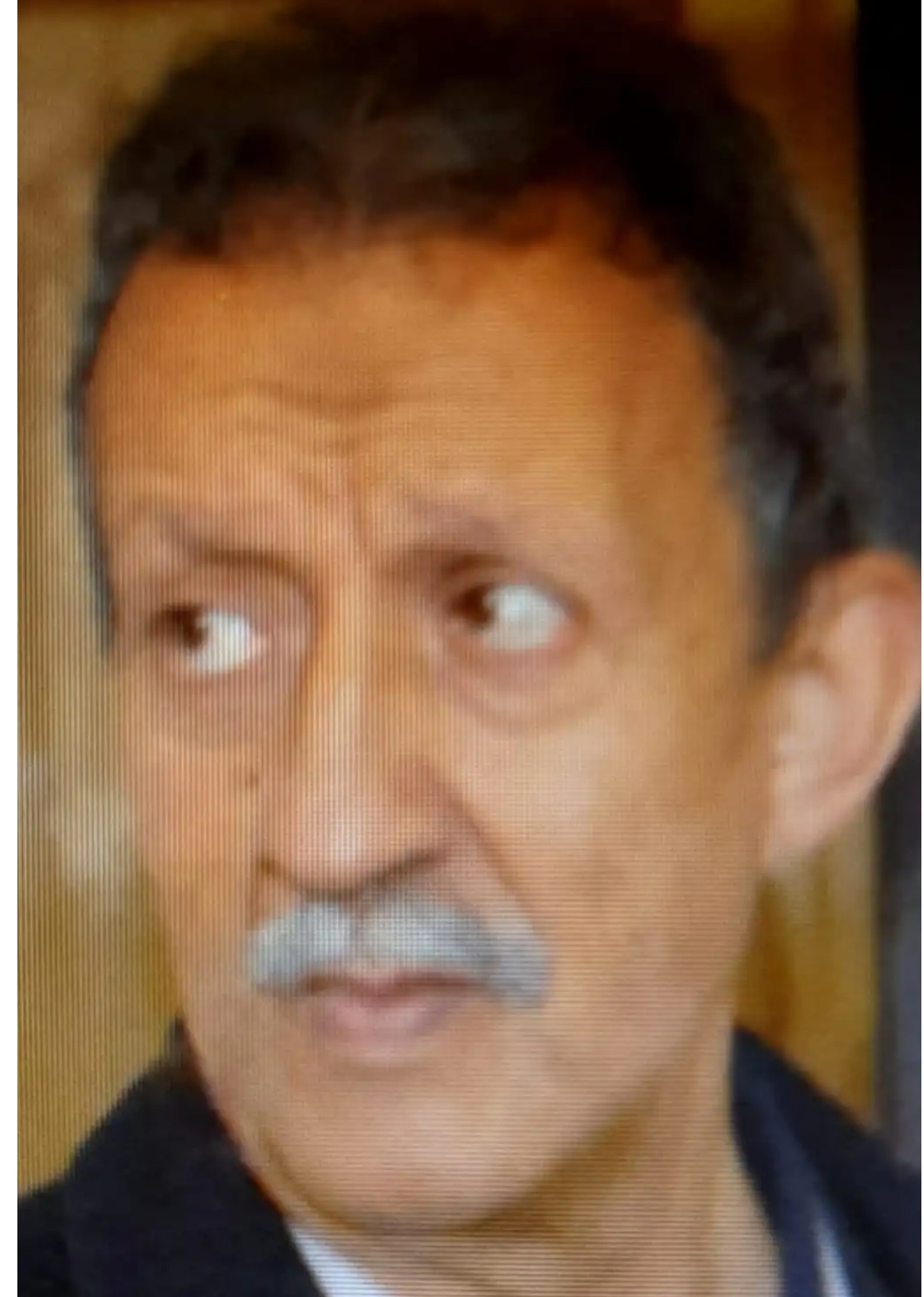


تعليقات 0