جدلية السؤال والإجابة: مِرآتُنا الفاضحة بامتياز!!

عبد الحميد اليوسفي
————————-
أعتقد أن الفيلسوف الإغريقي سقراط، هو أول من تكلم في موضوع “السؤال والجواب”، فرأى أن الأسئلة أكثر أهمية من الأجوبة، لأنها تحفز العقل على الإنتاج والإبداع والاجتهاد… ومِن ثَمَّ فالأسئلة تشكّل مرآةً صادقةً على مدى تطور فكر السائل، وطريقة تَشَكُّلِ فهمِه ومدى استيعابه لما يدور حوله، من فوقه ومن تحته وأمامَه وخلفَه وعن يمينه وعن يساره، حتى أن بعض المفكرين كان يرى أن الأسئلة تحمل في طياتها وفي رحمها أنصاف أجوبتها، وبالتالي فما على المُخاطَب بالأسئلة إلا أن يبحث عن أنصاف أجوبتها الباقية!!
إنّ هذه العلاقة الجدلية بين السؤال والجواب تجعل الأسئلة، على الخصوص، تُميط اللثام عن طبيعة السائل، وعن علومه ومعارفه، وثقافته ونمط تفكيره، وربما أيضاً عن ميوله الفكرية والعقدية والأيديلوجية، وعن مجالات أخرى لها صلة وُثْقَى بِهُوِيَّته… فكيف ذلك؟
عندما نوجّه بحثنا واستطلاعنا على سبيل المثال شطر بلدان الشمال والغرب، وبلدان آسيا القصية كاليابان، والصين، وبلدان النمر الأسيوي، أقصد الكوريتين وطايوان وما جاورها… نجد الأسئلة السائدة في هذه الأصقاع منكبّةً، بالدرجة الأولى، على ميادين علمية ومعرفية مختلفة، كالكيمياء بكل تفرّعاتها، وكالفيزياء بكل شُعَبها، الطاقوية، والفضائية، والضوئية، والكهرومغناطيسية، وعلى الإشكاليات الرياضية (من الرياضيات لا الرياضة)، وعلى أمور أخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الحديثة، وبمستجدات الإكتشاف والاستكشاف في مجالات الذرة، وأجهزة النانو الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتصوير المجسَّد بالهولوغرام بأبعاده الثلاثة، التي تجعل منه إحدى “معجزات” هذا العصر، وإن كانت في حقيقتها عبارة عن “آيات”، لأن العلم الذي انبثقت منه علم ربّاني، وبالتالي فرَبُّ العزة هو الذي جعله في مَكامِنَ خفيةٍ يستطيع أن يلج إليها العقل الإنساني بمشيئة الله (“ولا يحيطون بشيء من علمه إلى بما شاء”)!!
ولأنّ الأسئلةَ في تلك البلدان ابنةُ بيئنها، ويسير سَوادُها الأعظم في هذا الاتجاه، فإنها تقدم لنا بكل أريحية فكرة واضحة المعالم عن الشعوب والأمم التي يتناسل فيها هذا النوع من الانشغالات، ولا نحتاج هنا إلى كثير آطناب، إذ يكفينا النظر إلى أحوال تلك المجتمعات وإلى مستويات تقدمها وتطورها لنتأكد، بل لِنُوقِنَ، بأن لتلك الأحوال علاقةً وطيدةً لا تنفصم بذلك الضرب من الأسئلة… وأرجو أن يكون قصدي من هذا القول قد تجلى بالوضوح اللازم!!
لْننتقِلِ الآن إلى بلداننا العربية المسلمة، ولْننظُرْ فيما يطرحه شبابُنا وكٌهولُنا ونسوتُنا وأبناؤُنا وبناتُنا من الأسئلة… لنجد أشكالاً تستطيع أن تقتل من الضحك او من الغُبن والوَجَع وهذه نماذج من أمثلة حية:
كيف نخرج من البيت صباحاً وما الدعاء الصالح لذلك؟ وكيف ندخل إليه عند العودة وبأي دعاء؟ وبأي قدم نبدأ الدخول؟! هل يجوز أن نأكل الطعام باليد اليسرى بدل اليمنى بدون عذر مقبول؟ هل نقبض الأيدي والسواعد أثناء أداء الصلاة أم نسدلها على الجانبين؟ هل نضع إبريق الماء على مَيامِنِنا في دور المياه أو على شَمائِلِنا؟ هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تستاك وتكتحل لاستقبال زوجها؟ وهل تبدأه هي بالتحية أم تنتظر أن يكون هو البادئ؟ هل يَحِلُّ للزوجة أن تُغني أو تُنشِد لزوجها وأطفالها رغم “حُرمة الغناء”؟ هل يَحِلُّ لها أن ترقصَ أمامه أو تراقصَه على انفراد أو أمام الأطفال رغم “حُرمة الرقص”؟ هل يَحِلُّ للزوجة ان تُصاحب زوجها إلى المسارح ودور العرض السينمائي أم أن ذلك أيضاً من المحرمات؟ هل يحق للزوجة أن يصدح صوتُها بتلاوة القرآن أم أن ذلك مباح للزوج وحده لأن صوت المرأة عورة؟!!
ألا ترون، يا حضرات، أن هذه الأسئلة وما شابهها تشكّل بكل تأكيد، وببداهة لا يرقى إليها الشك، عنواناً لأحوالنا، ولتصنيفنا في آخر سلم ترتيب الشعوب والأمم في مشارق الأرض ومغاربها، في وقت نُمسك فيه بين أيدينا كتاباً حكيماً قِيَماً يحُضّنا من بدايته إلى خاتمته على إعمال العقل، بل يأمرنا بذلك، قراءةً وبحثاً، وسيراً في الأرض وتمحيصاً في آثار الأولين والآخرين، وتقليماً للمعارف والمعلومات والبيانات، واستنباطاً للقواعد والقوانين والنظريات، مثلنا في ذلك كمثل كل مجتمعات هذا الكوكب؟!!
ألا يتحمّل فقهاؤنا وأساتذتُنا ومعلِّمونا وشيوخُنا ومُرشِدونا النصيب الأعظم من المسؤولية عن هذه السقطة المدوية والمرعبة، والتي ما زالت تسحبنا إلى الأسفل، حتى ونحن ندّعي الانتماء ككل شعوب العالم إلى هذا القرن وهذه الألفية؟!
ثم بربكم… وأخذاً بعين الاعتبار لما سُقْناه في بداية هذا المقال عن جدلية السؤال والإجابة، ألا تعبّر أسئلتُنا الأخيرة هذه، رغم ما تحمله في ثناياها من الألم والحسرة والاِلتياع، عن رغبة جامحة في الخروج من هذا العنق، الضيّق إلى درجة الانسداد، وعمّا يمكن وصفُه ببداية الخروج الفعليّ ولكن، شريطة البدء بإقبار أسئلتنا التافهة والعَبَثية، وإيقاف تناسلها بيننا، وداخل دوائرنا وبين صفوفنا، عن طريق منح الدعم اللازم لمفكرينا المتنوّرين، الذين وضعوا على كواهلهم، من تلقاء ذواتهم، مسؤولية تبديد العتمة التي ألقاها تراثنا الهجين على عقولنا فعطلتها لمئات السنين، والتي ذرّها شيوخُنا الأوائل والأواخر في أعيننا فأصابتنا بِرَمَدٍ لا يُشفيه إلا التنوير بالفكر والقول والفعل، ولتذهب إلى الجحيم مقولات “حُراس الصندوق”، و”كهنة المعبد”، و”سدنة الدين الموازي” الذين ظلوا جاثمين على صدورنا منذ بداية العهد الأموي وإلى غاية ساعات الله هذه؟!!
تُرى هل يسعنا أن نتمسك بهذا الأمل دون أن تُوَجَّهَ إلينا كالعادة فُوَّهاتُ مدافع التمريق والزندقة، وقذائف التخوين والتكفير؟! هل نستطيع القبض على خيوط هذا الأمل؟!!


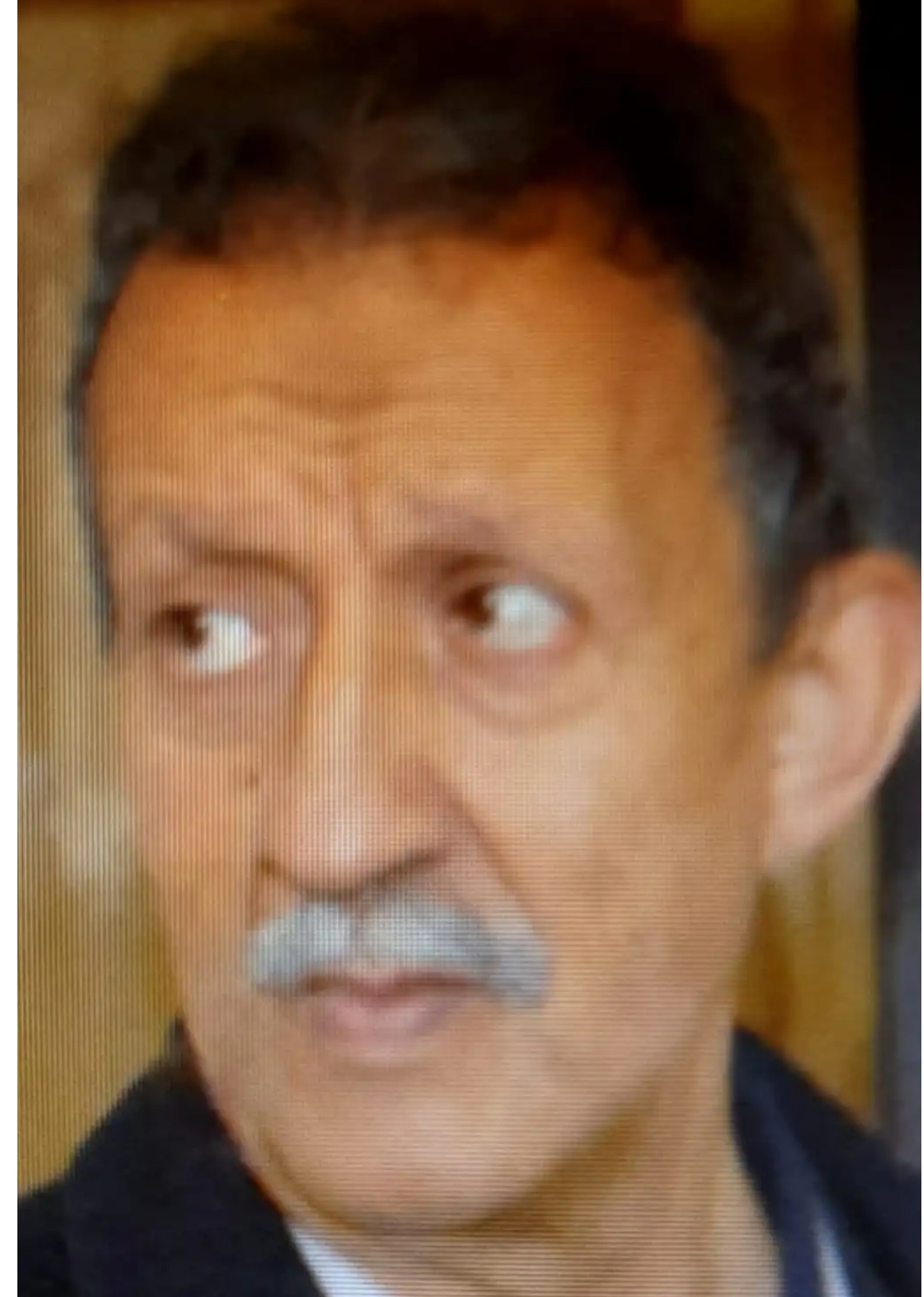


تعليقات 0