إشكالية قراءتنا الملتبسة للنصين التاريخي والديني!!

في الواقع، ينبغي علينا أن نُقِر منذ بدء هذه المناقشة بأن الأمر يطرح ليس إشكالية واحدة فحسب، كما يبدو في العنوان أعلاه، بل إشكاليات، وأنّ هذه الإشكاليات تتعدد وتختلف بتعدد واختلاف زوايا القراءة والعقول القارئة، الباحثة والدارسة… أما عامة المتلقّين فهذا الأمر يتجاوزهم بالفعل، وبالقوة أيضاً، لأنهم يُشكّلون السواد الأعظم من الضحايا، إذْ هُمُ الحطب الذي يستهلكه رواد الفكر لإيقاد شُعلاتهم الفكرية والمذهبية، وأحياناً الأيديولوجية، رغم مَوت الأيديولوجيا وذهابها إلى غير رجعة.
ذلك، أن بعض “المفكرين” لا يزال يعيش في بحبوحة “العقل المؤدلج”، ضداً على كل التيارات الفكرية السائدة في هذا الزمن الملتبِس… زمن تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتواصل، والهواتف الذكية… أقصد، الأذكى في غالب الأحيان من حامليها!!
أولاً: هناك إذَنْ سلوك فكري واجب على كل من لديه “عقل شغّال”، بأن يميّز بكل وضوح بين الديني والتاريخي، على اعتبار أنهما يُشكّلان وجهين مختلفين لعُملتين منفصلتين عن بعضهما من حيث المصدر والجوهر معاً… فكيف ذلك؟ إن “الدين” نمطٌ فكريٌّ وسلوكيٌّ إلهيُّ المنبع، ولذلك يخضع لمصدر تشريعي واحد ووحيد، ومنفرد، هو الخالق، “رب العالمين جميعا”، بمختلف أنواعهم وأجناسهم وبلا استثناء. و”العالمين” إشارة إلى كل الكائنات، العاقلُ المكلَّفُ منها ونقيضُه، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فهو “إله العِباد” أو “العابدين إيّاه”، الذين يُدينون له بالخضوع والتسليم، ويؤمنون بالغيب، والذين يلتزمون بسُنَنِ الله الثابتة في خَلقه… أقصد المؤمنين بربوبيته وألوهيته في آن واحد… وهؤلاء يستمدون هذه العلاقة العمودية من مصدرين اثنين يُكمّل الثاني منهما الأول، وهما “الفطرة” و”النص المنزل”.
لكن، ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن هذا القول بوجود مصدرين، وإن كانا متكاملين، فإن أحدهما يمكن أن يُغني عن الآخر بشكل من الأشكال، وليس باللزوم أو بالضرورة. إذ قد تكفي الفطرة وحدها لتحقيق المعرفة بالحق، وهذا هو الحال لدى معظم أهل هذا الكوكب، برّاً وبحراً وجواً، وربما في أبعاد زمكانية أخرى ما زالت غيرَ مُدرَكة بالحواس… وبالتالي فالرسالات جاءت للتذكير ليس إلاّ.
ثانياً: إن “التاريخَ” نمطٌ فكريٌّ سِجالِيٌّ إنسانيُّ المصدر، وإنْ كان النص المنزل يقدم لنا شذراتٍ منه صيغت من لدن الحق عزّ وجل، ومن لدن الملأ الأعلى، على سبيل ضرب الأمثلة وتقديم الدروس والعبر، ولدينا في القرآن، على سبيل المثال، قصصٌ وتآريخ عن أحداث وأشخاص وأمم لم تكن قد طالتها الكتابة التاريخية البشرية بَعدُ.
إنّ “التاريخ” كما نُعَرِّفه، إبستيمولوجياً، ذو مصدر إنساني، وبالتالي يخضع للعقل، وللفحصِ العلمي الأركيولوجي والأنثربولوجي والفحصِ الوثائقي بمختلِف أنواعه وحوامله، ويخضع بتحصيل الحاصل للعقل، ولمنطق الأشياء، لأنه لو حدث وغادره العقل والمنطق فإنه يتحوّل إلى ما يُسمّيه النص المنزل “أساطيرَ الأولين”!!
نحن الآن أمام أمرين: أحدهما إلهي وبالتالي “مطلق” و”ثابت”؛ وثانيهما إنساني بشري، وبالتالي “نسبي”، و”متغيّر”، بل واجب التفيّر.
إن “الثابتَ” أزليٌّ وسرمديّ، و”المتغيرَ” فائت وزائل… فلا مجال إذَنْ لأن يختلط علينا هذان الأمران، اللهم إلا إذا صنعنا الخلط وفبركناه من تلقاء أنفسنا، عن قصد أو عن غيره، وهذا بالذات، هو مصدر الإشكالات التي انطلقنا من الإشارة إليها منذ البداية، وأشرنا بالمناسبة إلى أن لها فاعِلِين وضحايا!!
لا أشك أنكم فطنتم الآن إلى أننا هنا بصدد الحديث عما نسميه ب”التاريخ الإسلامي”، وهو اسم باطل، لأن التاريخ لا يمكن أن يكون “إسلاميَّ المنشأ”، ولا أن يكون بطبيعته “إسلامياً”، وإنما هو “تاريخٌ للأمة المسلمة”، وهذا هو الإسم الصائب، باعتبار أن “الأمة” المعنية هنا لا يجوز أن نسميها بدورها “إسلامية”.
إن الكيان “الإسلامي” يُفترض فيه أن يكون “دستوره الإسلام” كُلاًّ وليس بعضاً، وهذا لم يتحقق إلا مرة واحدة في تاريخ هذه الأمّة، وهي المرة التي أنشأ فيها محمد بن عبد الله، ليس بوصفه رسولا مبلِّغاً لرسالة ربه وإنما بوصفه نبياً مرشدا ومربياً، وزعيماً قائداً مؤسِّساً، أنشأ دولتَه الأولى، “الإسلامية” بكل الشروط والمعايير، والتي تغيرت طبيعتها وأُسُسُها الإسلاميةُ بمجرد وفاته، عليه أزكى الصلاة والسلام!!
إن التجاوز عن هذا التمييز المقصود:
* بين “الرسول” المبلِّغ للرسالة بلا نقص أو زيادة، والمتمتع من أجل ذلك بالعصمة؛
* وبين “النبي” القائد ورئيس الدولة، المفكر والمعلم والمجتهد والمبتكِر، والمتصف من أجل ذلك بالطبيعة البشرية بكل مناقبها وهنّاتها، وبكافة كمالاتها ونقائصها…
ذاك التجاوز هو رأس البلاء فيما نحن بصدد إثارته من إشكالات القراءة والفكر والفهم… ومرة أخرى، كيف ذلك؟!
لنبدأ بالقول إن سوءَ أو عدمَ التفريق بين مقامَي الرسالة والنبوة جعل أخبارا وقصصا كثيرة محسوبة بالأساس على المقام الثاني (النبوة) تؤخذ بردّها إلى المقام الأول (الرسالة)، من لدن “علماء” ليست لهم من هذه الصفة بالمعيار الإبستيمولوجي إلا الإسم، أي أنهم مجرد حُفّاظ ونُقّال تميّزوا بالكاد عن عامة أهل عصرهم بما حفظوه ونقلوه عن “آبائهم”، فوصفهم عامّةُ ذلك العصر بالعلماء… أقول كانت تلك الأخبار والآثار تؤخذ من لدنهم على قدم المساواة مع ما كان يُبلّغه الرسول إليهم من الرسالة المنزّلة، ولذلك وصل إلينا تراث يختلط فيه الناسوت باللاهوت، ويلتبس فيه ما هو من صميم الدين والشرع الإلهي بما هو مجرد كتابة تاريخية من فعل بشر، نبيا كان أو فقيها، وزاد في بَلّةِ الطين قولُ “العلماء” ذواتِهم “بالوحيَيْن” من أجل إلغاء ذلك التمييز قطعياً، فأدى هذا إلى اختلاط حابل التعاليم الدينية الربانية بنابل المعطيات التاريخية البشرية، فكان من بين آثار هذا اللبس أن أخذ بُسطاؤُنا تراث السلف من تفاسير وأخبار وآثار وروايات مأخذ الوحي، فتحولت أمور من صميم التاريخ إلى صميم الدين، حتى اتخذ بعضُ “فقهائنا” عادات وتقاليد من صُنْع السلف ومن اختلاق الرواة مأخذَ الواجبات الدينية، التي يستوجب اتّباعُها أو تركُها حُكماً فقهياً بالإيمان أو الكُفر!!
هذه واحدة من الإشكاليات التي نشأت عن الخلط بين الديني الرباني، والتاريخي الوضعي. بيد أن مصيبة المصائب أن هذا حدث وتفاقم وترسّخ على أيدي “علماء” يُفترض أن تؤول إليهم صلاحية ومسؤولية الكد من أجل اجتناب الوقوع في هذه القارعة!!
نعم… وكما يقول المثل الشهير: “حاميها حراميها”!!
فالفقيه أو العالم الذي كنا ننتظر منه تبديد هذا اللُّبس ونزع شوكاته المدمية من سُبُل فكرنا وفهمنا، إذا به هو الذي يتكفل بنصب المزيد من المَزالِق والمِطبات، وبث المزيد من الأشواك… وأوفى مثال على هذا الخلط الفظيع، ما تركه “شيخ الإسلام” تقي الدين أحمد بن تيمية، الذي أفتى بقتل تارك الصلاة، وقتل المرتد… بل وأفتى بقتل كل مَن يجهر بنيته لأداء الصلاة (!!!). والحاصل من وراء هذه الفتاوي، الدموية، أن بسطاء الأمة بتوجيه من “علمائها” و”فقهائها”، من السلف والسلفيين، اعتبروا تلك الفتاوي تعاليم دينية لا فرق ولا تمييز في ذلك بينها وبين الوحي المنزّل، ومِن ثَم شكّل ذلك تنظيراً اعتبره أولئك من الثوابت، فنشأت من جرّائه حركات إرهابية دموية، مثل القاعدة وداعش، تؤمن إلى درجة اليقين بأنها وحدها تمتلك زمام الحقيقة نقلاً عن مُنظّرها ابن تيمية… وما خَفِيَ كان أعظم!!
أعتقد أنّ من الأنسب في هذا السياق بالذات، أن نستحضر، بكل ما يقتضيه ذلك من التقدير والإعجاب والثناء، الرفضَ النبويَّ الصارم والقاطع لأيّ تدوين أو توثيق للحديث، وللروايات، والالتزام التام بهذا القرار النبويّ من لدن الخلفاء الراشدين الأربعة…
ونسجل في السياق ذاته، أن ذلك القرار الصائب لم يتعرض للإغفال والإهمال إلا بمجيء بني أمية، ونَشْأةِ الحاجة لدى هؤلاء إلى اجتراح “تعليمات” أرادوها أن تكون في مستوى “تعاليم” الشريعة، لكي يقضوا بها أغراضاً سياسيةً لم تَخْفَ حقيقتُها على أحد من العالمين، ثم تطوّر ذلك لديهم إلى فبركة شريعة موازية، ثم “دين موازٍ” نتج عنه تركٌ فاضحٌ للنص المنزّل، وهجرانُه، وإلقاؤه وراء الظهر، مِصداقاً لما جاء في القرآن الحكيم على لسان الصادق الأمين: “يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا” (الفرقان-30)!!
لقد كان محمدٌ بنُ عبد الله، من حيث كونُه رسولاً معصوماً، يُبلّغ رسالةَ ربه بالكامل وبكل الحذافير، بينما كان بوصفه نبياً ذا طبيعة بشرية، ويَعلم حق العلم أنّ ما كان يَصدُر عنه في مقام النبوة إنما هو “نص تاريخي”، وبعضٌ من التاريخ، ومحكومٌ بالتالي بِسُنّة الصيرورة والتّبدُّل والتطوُّر ثم الزوال، لارتباطه العضوي بمجتمع ذلك العهد، وبزمانه وبيئته وقضاياه… وكان يوقن، بالتالي، بأن ما كان يَصدر عنه في ذلك المقام لا يستحق التدوين حتى لا يُزاحم منطوق الرسالة، ولأجل هذا قال قولته الاستنكارية الشهيرة وهو يأمر بحرق كل ما دَوَّنه بعضُ صحابته من أحاديته: “أكتابٌ مع كتاب الله”؟!
الظاهر أن الصادق الأمين، بقولته الناهيةِ عن تدوين الحديث، كان يستحضر قول الله تعالى: “تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ” (الجاثية-6)!!
وهنا ينتصب أمامنا أمر آخر، في السياق ذاته، ولكنه أشد التباساً ومدعاةً إلى الخلط من كل ما سبق ذكره، ألا وهو القول ب”حديث” بل “أحاديث بالآلاف” غير “حديث الله” وآياته… وتلك إشكالية أخرى تحتاج إلى وقفة منفصلة، وإلى المزيد من الصبر على البلاء!!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي


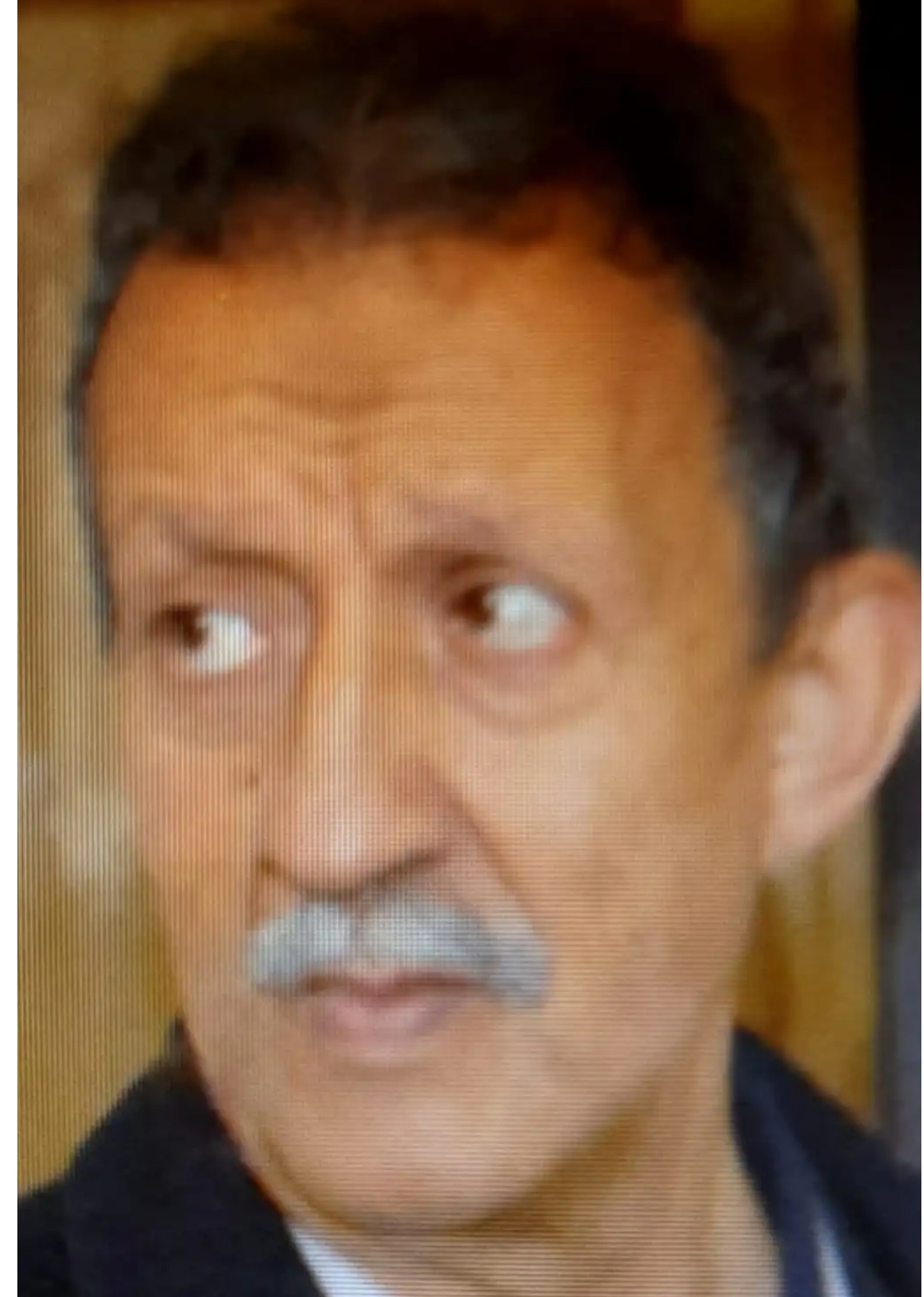
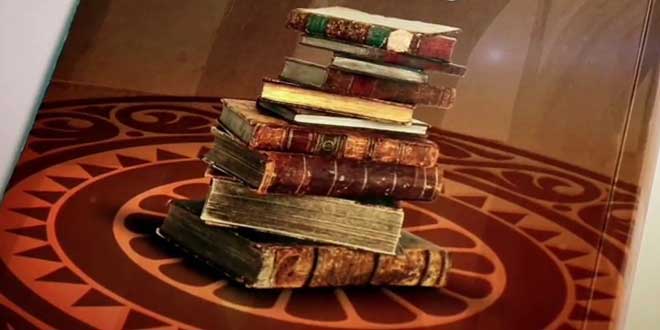

تعليقات 0