هنا القراءة.. والتلاوة.. والتجويد والتنغيم.. والحفظ… فأين ذهب التدبر؟!!

أعتقد أننا جميعاً في غيرما حاجة إلى تعريف المصطلحات الواردة في العنوان أعلاه، “ولكن ليطمئن القلب”، سنمر عليها بسرعة حتى ننطلق في فهمنا من أرضية اصطلاحية ومعرفية واحدة.
1- القراءة:
هذه ليست مرادفاً للتلاوة كما يقول أغلبُ المفسرين ومقدّسو معاجم اللغة. فالتلاوة إذا كانت تتحقق باللسان، أي بالمنطوق، فإن القراءة تتحقق بالغَوْص في المقروء من أجل التّعرف على تفاصيله، ولذلك جاء الأمر الإلهي الأول إلى رسول الهدى: “اقرأ” (العلق -1) بمعنى القراءة في كتاب الوجود، ودليل ذلك توجيه النظر في السورة ذاتها إلى “الخلْق” ثم إلى “القلم”، الذي يعني “تقليم” المعلومات والمعطيات، أي تصنيفها، ثم ترتيبها ليسهل الولوج إلى تفاصيلها ودقائقها، وليس ذاك مجرد يراع كالذي نستعمله في الكتابة الخطية، كما جاء بتفاسير في غاية البدائية؛ وكذلك لُفِتَ النظرُ إلى “العلق” الذي يدخل في مناط البيولوجيا أو علم الأحياء… وهذا كاف للدلالة على أن القراءة المأمور بها في بدايات التنزيل الحكيم تعني الدعوة إلى تَصَفُّح “كتاب الوجود” والطبيعة والكائنات بمُختلِفِ ضُروبها وأشكالها!!
في هذا المعنى أيضاً، والمتصل بالقراءة، جاءت الآية: “وإذا قُرِئَ القرآن فاستعمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون”
(الأعراف – 204). فالإنصات لا يكون للأصوات، وإنما يكون للمعاني والمقاصد والدلالات. وكذلك معنى “الاستماع”، الذي يشكل بُعدا أعمق من مجرّد “السماع”. ف”استمعوا” لا تعني “اسمعوا”… ذلك أن الاستماع يتطلب القيام بفعل داخلي جَوّاني أثناء السماع، تماما كما هي العلاقة بين “الفعل” و”الافتعال”… فالأول ظاهري جلي، والثاني فيه تَدَخُّل لذات الفاعل فيصير مُفتعَلاً أي مُضافاً إليه شيءٌ من إرادة الفاعل يتيسّر به الولوج إلى مستوى أعمق من الفعل ويتحقق به “التفاعل”.
نَخلُص من هذا إلى أن فعل “القراءة” يتعدّى مدلول “التلاوة” ويتخطاه إلى التفاعل مع موضوعها ليَصير مقروءاً ومعقولاً، بعد أن كان منطوقاً باللسان فحسب.
نفهم من هذا أيضاً، وبتحصيل الحاصل، أن التلاوة مجرد إخراج للنص من الورق أو من أي حامل آخر إلى عالم الأصوات، فيصير مسموعاً، أي كياناً صوتيّاً وليس أكثر.
لذلك أيضاً، جاء التعبير القرآني “يتلونه حق تلاوته” (البقرة – 121) إشارة إلى عدم التلاعب بمفرداته بالتغيير أو التعديل فيها حتى لا يطال ذلك معانِيَها، عملا بالمبدأ المعمول به في “منطق اللغة”: “إذا تغيّر المبنى تغيّر المعنى”، وهو المبدأ الذي ينبغي الحِرصُ على الالتزام به في قراءة آيات الذكر الحكيم، لأن القرآن لا يتغير فيه مبنى أي كلمة من كلماته إلا بغرض إحداث تغيير في معانيها ومَراميها.
مثال ذلك: الرسم المزدوج للفعل “رأى”، و”رءا”، حيث دلّ الأول على رؤية معنوية فؤادية كما في الأحلام، بينما دل الثاني على رؤية جسدية فيزيقية كما في البيت أو الشارع العام.
لأجل ذلك ينبغي الحرص، عند “تلاوة” آيات الذكر الحكيم، على التقيّد الصارم بمخارج الحروف والكلمات والأسماء والأفعال، مع الانتباه لرسومها، لكي يتيسّر على ضوء ذلك فعل “القراءة”، الذي يتخطى “المنطوق” إلى “المعقول”.
2- التجويد:
بخلاف فعلَي التلاوة والقراءة، المختلفين أساساً، يأتي “التجويد”، كما نفهمه في استعمالاتنا اللغوية الاعتيادية، للدلالة على تلاوة يطالها التحسين والتجميل، ولكن ذلك يتم بأسلوبين مختلفين:
الأسلوب الأول:
لا يتخطى التدقيق في مخارج الحروف، من حيث الصوت من جهة، ومن حيث شكل الكلمات من جهة ثانية، بمعنى إعرابها، بحيث ينزل الرفع والنصب والجر والجزم في مواقعها الملائمة طبقا لقواعد النحو والصرف، مع اعتبار الرسم القرآني في هذه العمليات “هو الأساس والمصدر الذي ينبغي أن نضبط ونصحّح به لغتنا العربية” وليس العكس.
إنّ الرسم القرآني، المُنْزَل ب”اللسان العربي المبين”، هو الأصل والأساس، وليس ما لدينا في معاجم اللغة بكل تأكيد. ولا ريب أننا جميعاً قد طالعتنا في معرض دراستنا لهذا الموضوع حالات اعتَمَد فيها بعضُ القرّاء والمفسرين على اللغة المعجمية فأدى بهم ذلك إلى تحريف معانٍ قرآنية كثيرة عن مَواضِعها.
مثال ذلك: وضع فواصل في غير محلها، كما وقع في القراءة المختلفة للآية: “…لا يعلم تأويلَه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌّ من عند ربنا…” (آل عمران – 7) ففهم البعض “أن تأويله يعلمه الله والراسخون في العلم”؛ وفهم بعض آخر “أن تأويله لا يعلمه إلا الله وحده”، و”أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا”، فما أوسع الهوّة بين هاتين الدلالتين!!
مثال آخر: في قصة امرأة عمران، التي وضعت وليدتها فجاء في الآية على لسانها: “إني وضعتها أنثى – والله أعلم بما وضعت – وليس الذكر كالأنثى”… فوضع البعض فاصلا اعتراضياً – كما فعلتُ أعلاه – يجعل مقولة “وليس الذكر كالأنثى” صادرة عن امرأة عمران، التي كانت تتأسف لعدم إنجابها للمولود الذكر، الذي نذرته مُسْبقاً لخدمة رسالة ربها، وهذا يقتضي جعل مقولة “والله يعلم بما وضعت” مجرد جملة اعتراضية منفصلة عما سبقها وما تلاها؛ والبعض الآخر لم يعتبر هذه الجملة اعتراضيةً فجعل التعبير “وليس الذكر كالأنثى” صادرا عن الحق عز وجل، فخَلُصَ من ذلك إلى إثبات المرتبة المتدنّية للإناث، واعتبارهن بالتالي أقل قيمة ودرجة ومكانة من الذكور… وهذا غير لائق في حق الله جل وعلا، الذي ينبغي أن يفهم ذوو الألباب أنه ساوى بين الذكر والأنثى في كتابه الحكيم، إحقاقاً لعدله المطلق!!
الأسلوب الثاني:
أن التجويد أخذ مناحي في غاية الاعوجاج خرجت به عن مقاصده الأولى، الأساسية، التي كانت تهدف إلى تجميل الكلام الإلهي والربّاني من باب تقديره وتقديسه وإعلاء شأنه… فصار التجويد من جراء مُغالاتنا في ذلك “تنغيماً”، حتى بتنا نجد في الأسواق تِلاوات متنوعة بِتَنَوُّع المقامات الموسيقية: تلاوة بالنهوند، وتلاوة بالسيكة، وأخرى بالبَياتي، أو الصابة… فتحولت تلاوة القرآن إلى ما يشبه الغناء، وصارت آياته من جراء ذلك أشبه ما تكون بأشعار العرب ومواويلهم، وكل ذلك لا يمكن أن يكون إلا مذموماً لذاته ولآثاره، لأنه حوّل القرآن إلى ظاهرة صوتية “أكوستيكية” بدلا من كونه كتابَ إرشادٍ وإصلاحٍ وهِداية!!
3- الحفظ:
تعددت وصفات حِفظ القرآن عن ظهر قلب، وتيسير استظهاره، فشكّل ذلك، هو الآخر، انحرافاً عن مراد الله في تنزيله لآياته المخاطِبة للعقول والألباب، فصارت تُخاطب مراكز التذكّر والاستظهار في الأدمفة. ولئن كان حفظ القرآن مطلوبا في القرنين الأول والثاني للهجرة، فإن ذلك كان له ما يبرره قبل تطور الكتابة، والتوثيق، ثم الطباعة بمختلِف مستوياتها، ثم التخزين بالصوت، ثم بالصوت والصورة، ثم التخزين والمعالجة بتكنولوجيا الإلكترونيات، ثم الرقميات… فأي سبب يجعل المرء في زمان الله هذا يُنفق وقته وجهده وعمره في عمليات حفظ لا ترقى، ولن ترقى أبداً، إلى مستويات التخزين والتوثيق الإلكترونيَيْن والرقميَيْن الراهنَيْن؟!!
الأدهى من كل ما ذُكِر، أن التلاوة لذاتها والتجويد والتنغيم والحفظ ألقت كلها بكلكلها على علاقتنا بكلام الله، فتحولت إلى علاقة ملتبسة لأنها افتقرت إلى عصبها الرئيسي، المتمثل في فهم الكلام، واستيعاب مقاصده، وإدراك مراميه بالتأمل والتفكُّر والتدبّر، لأن هذا بالذات، هو الذي يجعل ذلك الكلام نافعا وذا جدوى، ويجعل مَقاصِدَه ومَرامِيَه تتجلى في معيشنا اليومي، فنكون في مستوى تحقيق السلم والأمن في ذواتنا ومع أنفسنا، ثم في مستوى منح السلام والأمان لغيرنا بلا أدنى استثناء، لأن هذا هو عين “الإسلام”، وعين “الإيمان”، ولأنه بالذات، علة نزولِ الرسالات وبِعثةِ الرسل والأنبياء!!
ويبقى السؤال ثقيلاً، مثيراً للقلق وقاضّاً للمضاجع: “كيف السبيل للعودة إلى كتاب الله بالعقل والعلم والمنطق، بدلا من إقبالنا عليه، كما هو حالُنا اليوم، بالألسنة والأصوات الرنانة فقط لا غير، وربما غداً بالدفوف والأوتار والمزامير”؟!!
نسأل الله في ديننا وفي فهمنا لمراده السلامةَ والعافية!!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي


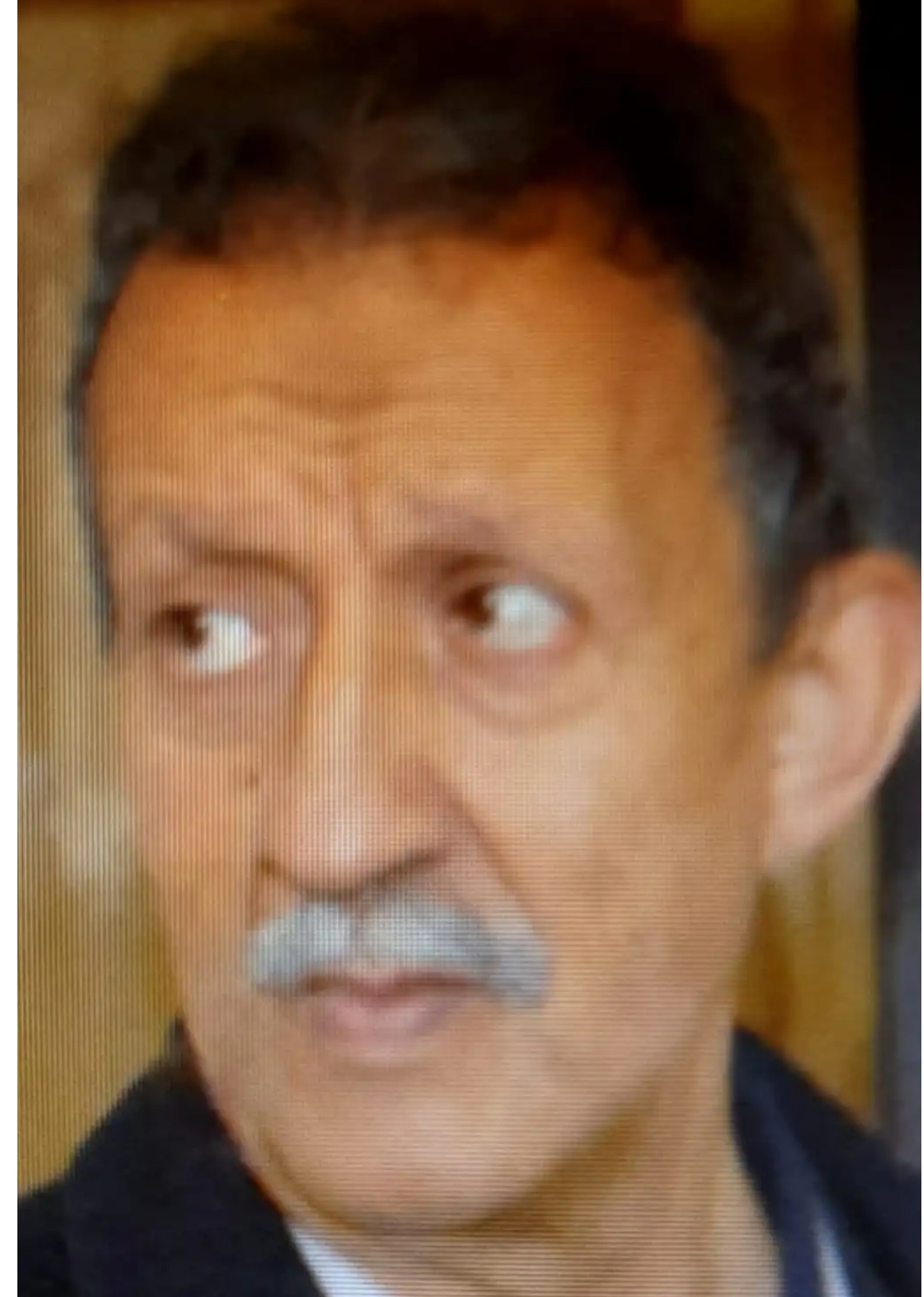
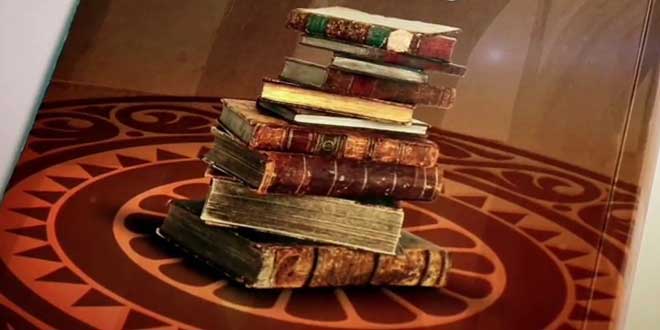

تعليقات 0