العذر عند “علماء” السلف..أنهم في معظمهم لم يكونوا علماء!!

بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي
————————–
بأي معيار تريدون أن نحسم في هذه المسألة، دون تشنج أو هيجان لا فائدة ترجى منه، ودون الانحياز إلى أشخاص لا يَعرِف عنهم المنحازُون إليهم شيئا سوى ما وصفهم به معاصروهم من الأُمّيين البسطاء، أو مِن تلاميذهم ومُريديهم المتزلِّفين لهم، أو من الأتباع المُسلمين قيادَهم لشيوخهم في تغييب تام للعقل… ولماذا يحتاج الواحد منهم إلى عقله وشيوخُه يصفون العقل خارج دائرتهم بالدابة، وبالحمار، كما قال شيخهم السلفي الوهابي “العالم” محمد حسين يعقوب، الذي يأمر مريديه ومتتبعيه بعدم استعمال العقل إلا في قراءة الحدود، بمعنى البحث فقط في العقوبات الشرعية، لأن العقل في اعتبار هذا “العالِم” من خصوصيات شيوخ السلفية دون غيرهم، أمّا باقي عباد الله فمجرد دواب وهَوامّ ينبغي أن تقنع بالاتّباع، ولا شيء غير الانصياع والاتّباع!!
ونعود إلى “علماء الأمة”، من السلف تحديداً، لنجد أنهم يستحيل أن يستقيم لأحدهم وصف “العلمية”، لأن العلوم في عصورهم وعهودهم لم تكن قد دخلت بَعد إلى “دائرة الحُفّاظ والنقّالين” الذين كان السواد الأعظم من أبناء هذه الأمة من الأميين والجُهّل وبسطاء العقول يصفونهم بالعلماء، وما هم بالعلماء حقّاً، كما أكدتُ على ذلك في مقالات سابقة، وإنما كانوا يحفظون كل ما يقع بين أيديهم، وينقلون عن بعضهم البعض، وينسبون لذواتهم ما ليس لهم فيه نصيب، فيدّعون امتلاك معارف ماهي إلا منقولة، بل مسروقة، وكثيراً ما يتضح فيما بعد أنها باطلة فتصيبهم بسهام الفضيحة، كما وقع “للعالِم” الطبري على سبيل المثال، الذي فضحته طالبة باحثة مصرية، قبل سنوات قِلائل، بين دفتي أطروحة جامعية قدمتها لنيل شهادة الدكتوراه، أثبتت فيها أن نسبة كبيرة من تفاسيره منقول عن الإسرائيليات، حتى أنها حرصت على وضع مقولات الطبري في صفحات عل يمين القارئ ومصادرها الأصلية باللغة العبرية في الصفحة المقابِلة، ليتضح أن “العالم” الجهبذ كان ينقل عن كهنة بني إسرائيل حرفيا، وبلا أدنى جهد يمكن أن يخفف عنه هذه التهمة الجسيمة، أن ينقل عن كهنة بني إسرائيل ما يسميه تفسيرا للقرآن الحكيم (!!!)
ولذلك فلا عجب أن نجد في إنتاجه أمورا يستحيل أن تفيد أي قارئ، مؤمناً كان أو غيرَ مؤمن، لأن عمله يصير بلا هوية، وبلا قسمات، فلا هو إنتاج نابع من تفكير نزيه يستهدي بالمصدر الديني الأوحد والأمثل والآمِن، وهو القرآن الحكيم، ولا هو بالعمل العلمي النابع من جهد علمي وبحثي جهيد يستوفي شروط العلمية الحق، التي عرفناها في عصرنا الراهن من خلال مقاييس “الإبستيمولوجيا”، أو “عِلم العِلم”، التي في وسعها وحدها، إلى أن يثبت عكسُ ذلك أو خِلافُه، أن تقول لنا عن أي مجال معرفي في أي مضمار بحثي هل تتوفر فيه شروط العلمية حتى يتسنى لنا أن نعتبره عِلما من العلوم المعترَف بها إنسانياً وكونياً، ونعتبر حامله بتحصيل الحاصل عالِما حقا!!
الطبري ليس سوى نموذج ضربتُ به المثل ليس إلاّ، أما أمثالُه فعزيزون عن العد والإحصاء، ويكفي أن نذكّر بأن من يسميهم بسطاؤنا بعلماءِ الأمة وفقهائها هم الذين منعوا وصادروا وأحرقوا مخطوطات فلاسفة/علماء حقيقيين أمثال ابن رشد وابن سينا والخوارزمي واتهموا هؤلاء ونظراءَهم بالزندقة والمروق، ورموا بعضهم بالكفر والشرك والإلحاد وأفتوا فيهم بالقتل، لا لشيء سوى لأن الإنتاج العلمي لهؤلاء كان يزلزل العروش التي تربّعوا عليها وتوارثوها أباً عن جد، وتلميذاً عن معلّم، ومُريداً عن شيخ، داخل أَبْهاء الجوامع الكبرى، ومجالس الفقه، ومنابر الإمامة، وحلقات التدريس والتلقين، ومَجامع الإفتاء… ونتيجة كل ذلك وعاقبته نعاينهما سيّئتَيْن وخيمتَيْن إلى غاية زمان الله هذا، وما زال بيننا للأسف الشديد مَن لا ينفكّون عن الحديث عن مصادر التشريع الديني فيحصون القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهم، جميعهم، يعلمون علم يقينٍ بأن المصدر الوحيد للتشريع الديني هو القرآن الحكيم بالنسبة لنا نحن المنتمين إلى الأمة المحمدية، وهو التوراة بالنسبة لقوم موسى، والإنجيل عند قوم عيسى، وإن كان هذان الأخيران على وشك أن يُشكّلا كتابا واحدا، ولذلك يسميهما معتنقوهما بالعهدين القديم إشارة إلى التوراة، والجديد إشارة إلى الإنجيل، ولذلك أيضا لم يذكر القرآن الإنجيل عند ترتيبه للرسالات، فذكر التوراة دون ما أُنزِل على عيسى، لأن الرسالتين تكملان بعضهما وتنسخ ثانيتهما بعض ما جاء من الأغلال في أولاهما… وقد بين القرآن ذلك بالوضوح الكافي والشافي لمن “ألقى السمع وهو شهيد”!!
ونعود كرّةً أخرى إلى “علماء الأمة” الأفذاذ، لنفهم كيف أنهم عند كتابتهم للتاريخ أشبعوا تآريخنا تحريفا وتزويرا، لأنهم كتبوها بعقول الأغيار، ومفاهيم الأغيار، كما سبق أن ذكرنا عن أعمال الطبري؛ وعند تفسيرهم لآيِ الذكر الحكيم قلبوا المعاني والدلالات فانقلبت المقاصد وضاعت السُّبُل إلى معرفة مراد الله في آياته البيّنات، ولم يكفهم ذلك فحرصوا على لَيّ أذرع بعض الآيات فعطّلوا أحكامها، ثم قالوا بنسخها، فطمسوا في الكتاب الحكيم كل آيات الرحمة والسماحة والتعايش والتساكن واستبدلوها، وقد فاق عددها العشرين بعد المائة، بما يسمّونها “آية السيف”، فشرعنوا بذلك غزو الآخرين تحت مُسمّى الفتوحات الإسلامية، وقتلوا وسَبَوْا وغنِموا في أوطان الغير، فزرعوا بذلك بذور الحقد والضغينة والمهانة لدى شعوب وأمم بعضُها لم يلبث أن مارس علينا انتقامه، كما فعل أعاجم الأندلس، حفدة أمبراطورية الروم، وأحفاد أباطرة بلاد فارس الذين يَحِنّون إلى أن تمارس علينا ثأرَها دولةُ إيران، التي يبدو لكل ذي لب أنها تتوق إلى استرجاع مجدها الآفل على حساب بلاد العرب قاطبة، ولذلك مددت أذرعها كالأخطبوط في الوطن العربي في كل الاتجاهات، حتى أنها صارت على مرمى حجر من بلادنا نحن المغاربة، بعد أن أهدتها الجزائر ونظامها الكسيح والفاسد مواقع شتى فوق ترابها، وهو تراب يبقى معظمه مسروقا من الجيران، وفي طليعتهم نحن المغاربة، وأهل تونس وليبيا وموريتانيا ومالي والنبجر… وفي كل هذه الأوطان لا تزال إيران تنثر بذور السوء لعلها تحصد ذات يوم طريقها إلى الأطلسي، وأنّى لها ذلك والمغرب لها بالمرصاد، بنفس الهمة التي رد المغرب وأفسد بها أحلام العثمانيين وأطماعهم قبل أن تتحول دولتهم إلى ما يسميه مؤرخو العصر الحديث بالرجل المريض!!
ثم نعود للمرة الثالثة إلى “علماء الأمة” الذين ما هم في حقيقتهم بالعلماء، لنجد لهم يداً مقصودةً أو غيرَ مقصودةٍ في كل ما أصاب هذه الأمة من الهوان، ومازالت على ذي الحال إلى إشعار آخر!!!
وأعود لأقول، مرة أخرى، إن علماء السلف لديهم ما يكفي من الأعذار لأنهم لم يكونوا حقّاً علماء، ولكننا نحن المفتقرون إلى كل الأعذار لأن بيننا سواداً أعظم يسبغ صفة العلمية على الأموات، ويلقي عليهم أرديةَ التبجيل والتقديس، والأدهى من كل ذلك، أن هذا السواد الأعظم يفكر ويرى ويسمع ويفهم ويمارس حياته في أدق تفاصيلها من خلال ما تركه ذلك السلف من ميراث يصعب أن نجد له أدنى مقارنة مع ما تفتق عنه عقل إنسان العصر الراهن، لأن المقارنة تستحيل مِن جرّاء هَوْل الفارق وجسامته!!
نسأل الله في ديننا وفكرنا وفهمنا وسلوكنا السلامة والعافية!!!


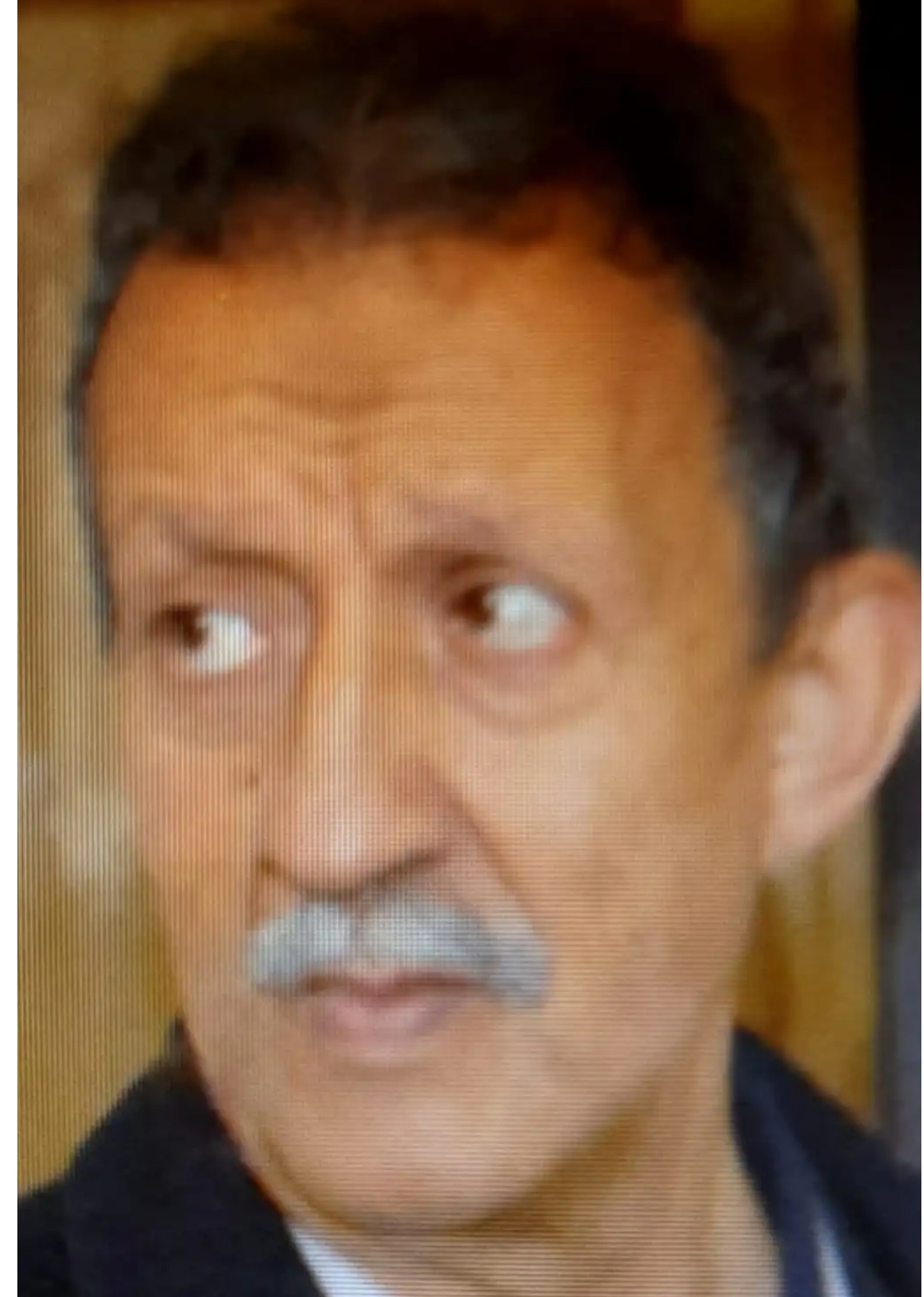


تعليقات 0