هل الإسلام يدفع إلى الإلحاد؟!!

الواقع بدايةً ان السؤال في العنوان أعلاه غريب فعلاً، لأنه يخالف المنطق. فالمنطق يقتضي أن لا يؤدي الخير إلى الشر أبداً، وإنما العكس هو الممكن والوارد!!
عندما يكون الإسلام منظومةً عقديةً وأخلاقيةً تعني “السلام”، وليس “الاستسلام”، وتعني تصدير الإخاء والمحبة والمودة للآخر، ويكون “الإيمان” متجاوِزاً “الإسلام”، ببَثّ الأمن والأمان والطمأنينة باتجاه الآخرين، بغض النظر عن معتقداتهم ومَشاربهم، وبالتالي تصدير البر والإحسان بلا مقابل دنيوي…
وعندما يكون ذلك السلوك الإسلامي والإيماني ليس مأخوذاً به خوفاً من القانون، أو من كاميرات المراقبة، أو من الشرطة وباقي آليات الزجر، أو يكون طمعاً في حظوة، أو مكافأة عاجلة، أو في قضاء مصالح آنية، وبالتالي قابلاً للانقلاب بمجرد غياب هذه الدوافع والآليات… وإنما يكون الإيمان، بخلاف ذلك كله، إرضاءً لرب العزة، وامتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه… وهذا هو المُراد من إضافة حرف “الباء” إلى وسيلة الإيمان في الصيغة: “بالله”…
وبالمناسبة، فمَن ربط الإيمان بالاعتقاد، فسيكون مرتكِباً خطأً جسيماً، وسيصعب عليه أن يفسّر لنا ما معنى أن يسمّي الله سبحانه نفسه باسم “المؤمن”؟! فهل معنى ذلك أنه يعتقد ويصدق بألوهيته؟! أليس هذا ليّاً لعنق الحقيقة الإلهية، التي تقتضي أن يكون رب العزة “مؤمناً” بمعنى: “مانحاً للأمن والطمأنينة لجميع خلقه بلا أدنى استثناء، الصالح منهم والطالح، المؤمن منهم والمجرم على السواء”؟!
عندما يكون الإسلام على هذا النحو، وهو المطلوب في كل الرسالات المنزلة، والنبوءات المبعوثة، فلا أعتقد أن في هذا الوجود الدنيوي مَن سيتركه ويختار نقيضه، لأن فطرة الإنسان، التي فطر اللهُ عليها جميع خَلقه، ترفض الفساد والإفساد أساساً، وتُجَرّم الاعتداء على الغير، أو أكل ماله ومتاعه بغير حق، أو انتهاك كرامته وحريته واستقلاله، أو قتله… مهما كانت المبررات.
خُلاصة القول، إن الإسلام بالمفهوم المشار إليه أعلاه، يسكن في فطرة الناس جميعاً، ومن غير المعقول ولا المنطقي أن ينقلب أحدٌ على أساسٍ ساكنٍ في صُلب خِلقته، وفي صميم تكوينه، ثم يذهب باحثاً عن نقيضه بلا أدنى دوافع أو مبررات!!
حسناً… فلماذا إذَن تتنامى أعداد المرتدين والملحدين في زماننا هذا، بالرغم من توفر الإسلام في هذا العصر على وسائل وآليات وأدوات، لو كانت مُتاحةً لدى المسلمين الأوائل، لَوَسِعَ دينُ الله كل بقاع الدنيا بلا أدنى منازع، لولا أنّ حِكمة الله وسُنّته الثابتة اقتضَيَتا ألاّ يكون الناس أمة واحدة، وأن يختلفوا ولذلك خلقهم، كما جاء في التنزيل الحكيم؟!
ما السبب إذَن في هذه الموجة المتفاقمة من الرِّدة والإلحاد؟!
وهل الإسلام، الذي هو الأصل، لأنه عين الفطرة، التي فطر اللهُ الناسَ عليها، يمكن أن يكون هو ذاته دافعاً إلى ذلك الانقلاب الجذريّ في الفكر والسلوك إلى نقيض الفطرة؟!
نعم بكل بأكيد، وهذا جواب صادم إلى أقصى الحدود ولكن، عندما نقرأ في تعاليم الإسلام، التي رفضها المرتدون والملحدون الجدد، نجدها في غاية الاختلاف والانحراف عما جاء به الأنبياء والرسل، وهناك من الأدلة ما يعجز عنه العد والإحصاء… فكيف ذلك؟!
سوف نكتفي لضيق المقام والمقال ببعض المعاينات على سبيل البيان وليس أكثر، وسيكون ذلك في غاية الكفاية.
1- إن “الدين”، الذي هو عند الله “الإسلام”، جاء واحداً أوْحَدَ، ومنفرداً، لا يقبل التعدد ولا التبعيض، ويجمع كل الرسالات والبعثات السابقة إلى آخر النبيين. وبالتالي فعندما نبحث في جغرافيا الإسلام وديمغرافيته، بالمفهوم المنوَّه عنه أعلاه، نُلفي أنفسَنا أمام أمم لا يمكن أن تكون إلا مسلمة. والإشارة هنا إلى “الأمم” وليس “الأنظمة”، والفارق شاسع بين المسمَّيَيْن، ولا داعي للخوض في تفاصيل هذا الفارق لأننا هنا ننشد الابتعاد عن السياسة.
لكن بمقابل هذا الواقع، الملموس، نجد “مفسرينا” و”فقهاءَنا” و”علماءَنا” قد أسبغوا منذ أكثر من ثلاثةَ عشرَ قرناً صفة الإسلام على أمة واحدة، هي “الأمة المحمدية”، ضاربين بعرض الحائط أقواما اعتنقوا ما جاء به أنبياؤهم ورسلهم من الهدى ودين الحق ومن الفرقان… وآخرون نهلوا من مشكاة النبوة بواسطة مُصلِحيهم وفلاسفتِهم وصُوفِيِّيهم… فأين الخطأ؟ وأين المعضلة؟!
2-إن الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل، وختمه نبينا الكريم، لم يشرّع لإجبار الناس على اعتناق الدين ذاته، بل شرّع للاختلاف، حتى أن النبي محمداُ بوصفه رئيس دولته أخرج قومه من حياة القرية، ذات الفكر الوثني الأحادي والشمولي، إلى حياة المدينة، فشرّع بذلك للتعدد والاختلاف، فاحتضنت دولته الأولى المسلمين، والمؤمنين، والمؤلفة قلوبهم، والكفار المسالمين، واليهود في صياصيهم، والنصارى في أدْيِرَتِهم، وآخرون من أقوام أخرى، وكان يُخضع كل هذا الخليط لنفس النظام المدني الذي استمده النبي رئيس الدولة المدنية من شرع الله، وشرع الله واضح وصريح بين دفتَيْ كتابه الحكيم.
3- هذه الدولة المحمدية الأولى لم تَصدُر إليها أوامر ربانية ولا نبوية بغزو الأمم الأخرى، فما كان من حروب النبي والمؤمنين معه ضد المشركين إلا دفاعا عن النفس وتثبيتا لأركان دولة السلام في مواجهة مُهاجميها والمعتدين على حُرماتها، وحين نقول “دولة السلام”، فمعنى ذلك أنها لم تكلف نفسها عناء إرغام غيرها من الدول على اعتناق الدين ذاته، رغم الحُلم الذي كان يراود النبي الأمين بنشر ألوية رسالته في كل بقاع الدنيا، ولكنه لم يَسْعَ إلى تحقيق ذلك الحلم لأنه بَلَّغ عن ربه قولاً صريحاً: “ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين”؟! (يونس 99) وهذا سؤال استنكاري ومانِع لا يقدر الرسول وهو مُبَلِّغُه على تَجاوُزه أو القفز عليه!!
4- كل هذا قابله دين آخر قائم على تفاسير باطلة، أو في أحسن الأحوال، ضعيفة وغير عالمة ولا عارفة، ومبني بموازاة ذلك على روايات حديثية “ظنية”، يستحيل أن ترقى إلى “قطعية” القرآن وثبوته وخلوه من أي شائبة، فصار الدين في “صيغته الوضعية” يأمر بالغزو، ويأمر بقتل اليهود والنصارى، وبالتضييق عليم وإرغامهم على دفع الجزية صاغرين، لأن هذا الدين الموازي يُكفّرهم، ويصفهم بالمشركين، وهذا الوصف بدوره في غير محله، لأن المشرك ليس هو الذي يعبد “مع الله” إلها آخر، بل هو من يرغمك على مشاركته مذهبه أو ملته أو دينه “باسم الله”، و”باسم دين الله”، ويمارس عليك كل أشكال العنف لتحقيق ذلك الغرض، ولذلك فهو مشرك “بالله”، وليس “مع الله”، وبالتالي فهو “الإرهابي” في ثقافتنا المعاصرة… والإرهابي مُحارَب في كل المجتمعات أينما حلّ، وأينما ثُقِفَ، مصداقاً لأمر الله تعالى الوارد في الآية التي سماها المشركون المتطرفون “آية السيف”، فأحلّوا بها لجماعاتهم قتل الأبرياء من كل الأجناس والأمم بغير حق، بما في ذلك أمّتنا نحن، فجنّدوا لذلك آلاف مؤلفة من الشباب الأمّي المُغَرَّر بهم، ووعدوهم بالجنة، وبسبعين من “الحور العين” لكل منهم، وهذا بدوره فهم باطل ومبطِل لاصطلاح “الحور العين”، الذي لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يشير إلى أنهن نساء “حور الأعين” (لاحظوا الفرق الشاسع بين الاصطلاحين)، فقتل هؤلاء المغرر بهم أنفسهم، وقتلوا معهم آلافاً مؤلّفة من الأبرياء بغض النظر عن مللهم ومشاربهم، وفيهم النسوة واليافعون والأطفال والعجزة من المدنيين العُزَّل، علما بأن هؤلاء الضحايا لم يحاربوا ديننا بأي وسيلة من الوسائل، رغم أن أنظمتهم على نفس منوال متطرِّفينا من الشرك والعنت والبغي!!
هذا التوجه الذي يفرضه السلفية وجمهور من فقهاء المنابر، القدامى أمثال تقي الدين ابن تيمية الذي أفتى بقتل تارك الصلاة، ثم أفتى بقتل المصلي إذا جهر بنية الصلاة (!!!) والمعاصرين أمثال يوسف القرضاوي الذي أفتى باللجوء إلى آلية تفجير الذات ووصَفَها بالشهادة، ومتولي الشعراوي الذي كفّر الرياضيين إذا اضطروا في رمضان إلى شرب الماء أثناء منافساتهم الرياضية، وكفّر من يتبرع بعضو من أعضاء جسده لإنقاذ غيره، وغيرهما ممن أفتوا بالقتل وبتحريم ما لم يحرمه الله عز وجل!!!
5- إن مؤرخينا فبركوا لنا ما سَمّوه “تاريخاً للإسلام”، وما هو بتاريخ الإسلام بل “تاريخ امة من الأمم المسلمة”، أسبغوا رداءً من القدسية على ما تعاقب فيه من الخلافات، التي نعلم جميعا بأنها كانت فاشلة لأن رؤوسها فيما بينهم تناوبوا على الحكم فيها ليس بالشورى، ولا بالاختيار الحر، وإنما بقتل بعضهم بعضا، وتلطيخ بعضهم أياديه بدماء بعض، ومن سخرية الأقدار أن ينادي من ذكرناهم من المتطرفين بالعودة إلى نظام الخلافة ذاتها، ويزيدون على ذلك بإشهار سيوف الخطابة النارية من أجل الدفع إلى تحقيق تلك الأجندة بالعنف والتقتيل… ونماذج “حسن البنا” و”عبد الحميد كشك” خَطابةً، و”أسامة بن لادن” تخطيطاً وتنفيذاً، تُغني عن الإطناب!!
هذا إذَن، وتحديداً، هو “الإسلام” الذي يدفع الشباب المُتَفَكِّرين دفعاً إلى الإلحاد، وإلى إنكار الدين جملة وتفصيلا، والدينُ القيّمُ مِن كل ذلك بَراء!!!
ذ. عبد الحميد اليوسفي


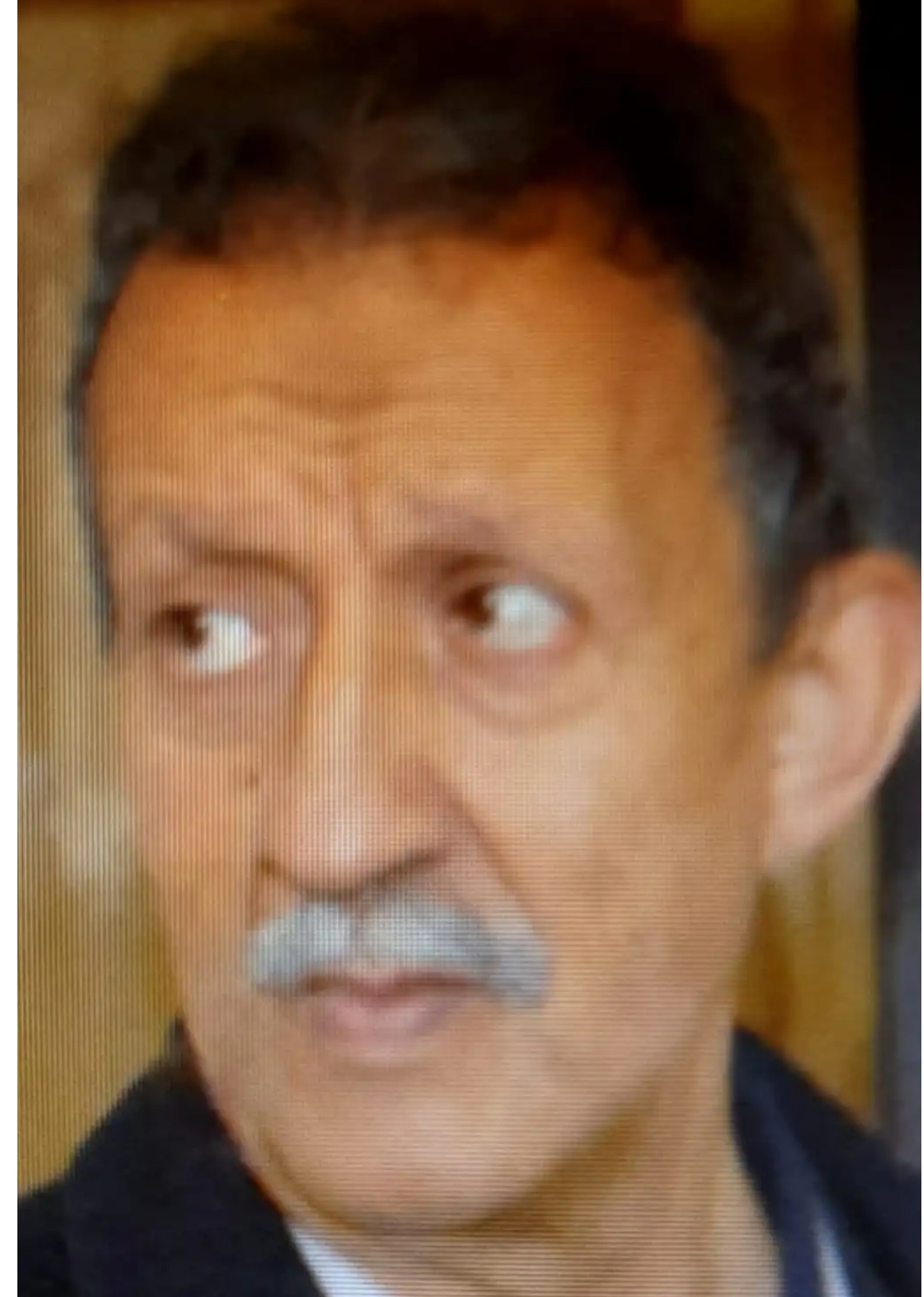


تعليقات 0