“إذا سألك عبادي عني…”..حوّلناها من “استجابة عملية” إلى “كلام لا يُسمِن ولا يُغني”!!

للأسف الشديد، أنّ حالَ هذه الأمة ومآلَها اللذين لا يُبَشّران بخير، ما هما إلاّ نتاجٌ منطقيٌّ وبديهيٌّ لِما فعله “أهل الحل والعقد” فينا، من “علماء” و”فقهاء”، و”مَشايخ”، و”مفسرين”، حرّفوا الكلم عن مواضعه بجعلهم كل ما دعا إليه الدين القيّم، من صالح الأعمال ونافعها، مجرد حركات بالأجساد، وكلام يُلاك بالألسنة، ويُنطَق بالحناجر ليس إلاّ، ولذلك انقطعت الصلة الجَوّانية برب العزة بسبب الابتعاد عن مناط تكليفه إيّانا بالعمل على تفعيل سننه وقوانينه، وركوننا مقابل ذلك، امتثالاً لتحاريف “رجال الدين”، إلى القول دون الفعل، والتمني دون الأخذ بالأسباب، التي ما خلقها مبدع الأسباب إلا لِتُفَعَّل على أرض الواقع، لا لتتحوّل إلى أصوات لا تختلف من حيث ثقلُها، في مَوازين الواقع، عن زقزقات الطيور، ونقنقات الضفادع، أو زئير الأسود والنمور، ولِمَ لا أيضاً نباح الكلاب ونهيق الحمير… شرّف الله قدركم!!
نعم… الحيوانات والطيور والزواحف تعبّر وتتفاعل “بالحركات والأصوات” فحسب، وكذلك فعل بنا “الكهنوت الديني”، بتحويل ديننا الفاعل والفعّال والعملي إلى حركات وأصوات نؤدّيها عند الصلاة، وعند الدعاء، وعند النجوى، دون أن نفهم قيد شعرة ما مفهوم الصلاة ولا الدعاء ولا المناجاة!!
إنك حين “تدعو” شخصا إليك فإنك تستحضره، لكي يتصل بك، بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة في زمانك، الذي يُشاركُك إيّاه، وحين تدعوه فإنك لا ترفع يديك إلى السماء وتنخرط في ذكر اسمه لكي تجده في حضرتك، بل إنك تأخذ بالأسباب فترسل له رسولاً ، أو تستعمل هاتفاً، أو برقاً، أو رسالة مكتوبة… وكذلك أراد رب العزة أن نعامله عند دعائنا إيّاه، الرامي إلى استحضار قدرته ومشيئته لتلبية حاجاتنا التي لا تنتهي، فلا نرفع أيدينا إلى السماء، في زوايا منازلنا ومساجدنا، ثمّ ننخرط في التضرع والبكاء والنجوى، بل نستجيب لما عرَضَه علينا من الأسباب التي هي الطريق “الرشيد” والصحيح إلى تحقيق رغباتنا مهما قل شأنها أو كَثُر… ولذلك جاءت الآية “إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” ( البقرة-186)، لتخبرنا بأن الله قريب، وأننا مطالَبون بالتوجه إليه بما وضعه بين أيدينا من الأسباب، وليس بالكلام فقط، لأن مفهوم الدعاء، الذي أخطأَ في تعليمنا إيّاه “مفسرونا”، هو الاستجابة المُسْبَقة عن طريق الأخذ بالأسباب، وقد خدعونا عندما فصلوا الآية عن سياقها، كعادتهم، فلم يركّزوا على الشرط الأساسي لتحقيق الاستجابة، الذي هو “الاستجابة القَبْلِيَّة” المطلوبة منا، والسابقة على الاستجابة الموعودة من لدنه سبحانه، والتي دلت عليها بقية الآية ذاتها: “فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”…
هناك إذَنْ شرط واضح وجليّ غضّ عنه المفسرون الطرف كأنْ لم يَكُنْ، بينما هو أساس الاستجابة المرجوة. أقصد: “الأخذ بالأسباب، كأساس للدعاء، بمعنى الاستحضار المستجاب”، الذي سبق القول إنه “استحضار بالملموس، وليس بالمنطوق فحسب، لقدرة الله المستجيب وفعله المتجلي في النتائج المتولّدة عن الأسباب”، ولأن الأسباب من تدبيره سبحانه، فإن نتائجها بالبداهة من صنعه أيضاً لأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ، المشتمل على السنن والنواميس الثابتة التي جعل الله منها نظاما سرمديا لكل أشكال العبادات والمعاملات، ومن هنا جاءت استجابته قطعية الدلالة والثبوت!!
إنّ العبادات والمعاملات، في مفهومها القرآني، لا تشكّل الحركات والكلمات فيها سوى ظاهرٍ لما يكمن وراءها من العمل الواقعيّ والملموس!!
إن هذا هو الذي يفسّر عدم جدوى أدعيتنا التي نلهج بها ليل نهار… ندعو على الظالمين والمعتدين فيزدادوا ظلماً وعدواناً، وندعوا على أمراضنا وآفاتنا الجسدية والنفسية فتستفحل وتتفاقم، وندعوا على من نَسِمُهُم بالكفر والشرك فيزدادوا قوةً وغَلَبَةً وسبقاً… وكل ذلك، لأننا أقصرنا الدعاء على الحركة والقول، نرفع أيدينا إلى أعلى ونقول، ولا شيء غير رفع الأيدي والقول، بينما المطلوب منا قرآنياً، لمن يقرأون القرآن بعقولهم وبصائرهم وليس فقط بألسنتهم وعيون رؤوسهم، أنْ نأخذ بالأسباب التي من شأنها أن تحقق لنا مبتغياتنا، لأن هذا من سنن الله وقوانينه التي جعلت الدعاء عملاً ملموساً، والاستجابة نتيجةً وعاقبةً هي بدَوْرِها بالملموس!!
إن هذه الحقيقة القرآنية الخالصة، التي غيّبها مفسرو العهود الماضية عن أبصارنا وبالتالي بصائرنا، بعد أن رسّخوا وجودها في أعيننا وألسنتنا، فقط لا غير، لا تقف عند الأدعية فحسب، بل تسري على مختلف جوانب الحياة المجتمعية والثقافية التي تتحدد على ضوئها عاداتُنا وتقاليدُنا بشكل عام، وما يتعلق منها بعقائدنا ومفاهيمنا الدينية بشكل خاص… وهنا منشأ أحوالنا المزرية ومآلاتنا المرثية وانتظاراتنا العصية على التلبية والتحقيق!!
والأغرب من تفاسير مفسرينا الباطلة والمبطِلة، أنهم فسّروا عدم الاستجابة لأدعيتنا السلبية وغير العملية بالقول المضحك والمثير للسخرية والأسى: “إذا لم يستجب الله لدعائك في دنياك فاعلم أنه خبّأ لك الاستجابة في آخرتك”… فياله من غباء مُرَكّب، لأن الآخرة كما عرّفنا القرآن على تفاصيلها موعد لوضع موازين القضاء الإلهي، وتفعيل آليات الحساب وقواعده العَلِيَّة والعادلة بالمُطلَق، وليست بأي حال من الأحوال امتداداً للحياة الدنيا بطلباتها ومشاغلها الدّنيّة!!
في المُحَصِّلة… أفلا يحق لنا أن نطمع في تغيير فكري ومفاهيمي إيجابيّ وعمليّ يعيد سُفُنَ فهمِنا إلى مرافئ “الرشد” و”الرشاد”… كما جاء في منطوق الآية ذاتها: “لعلهم يرشدون”؟.. ذاك هو السؤال!!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي


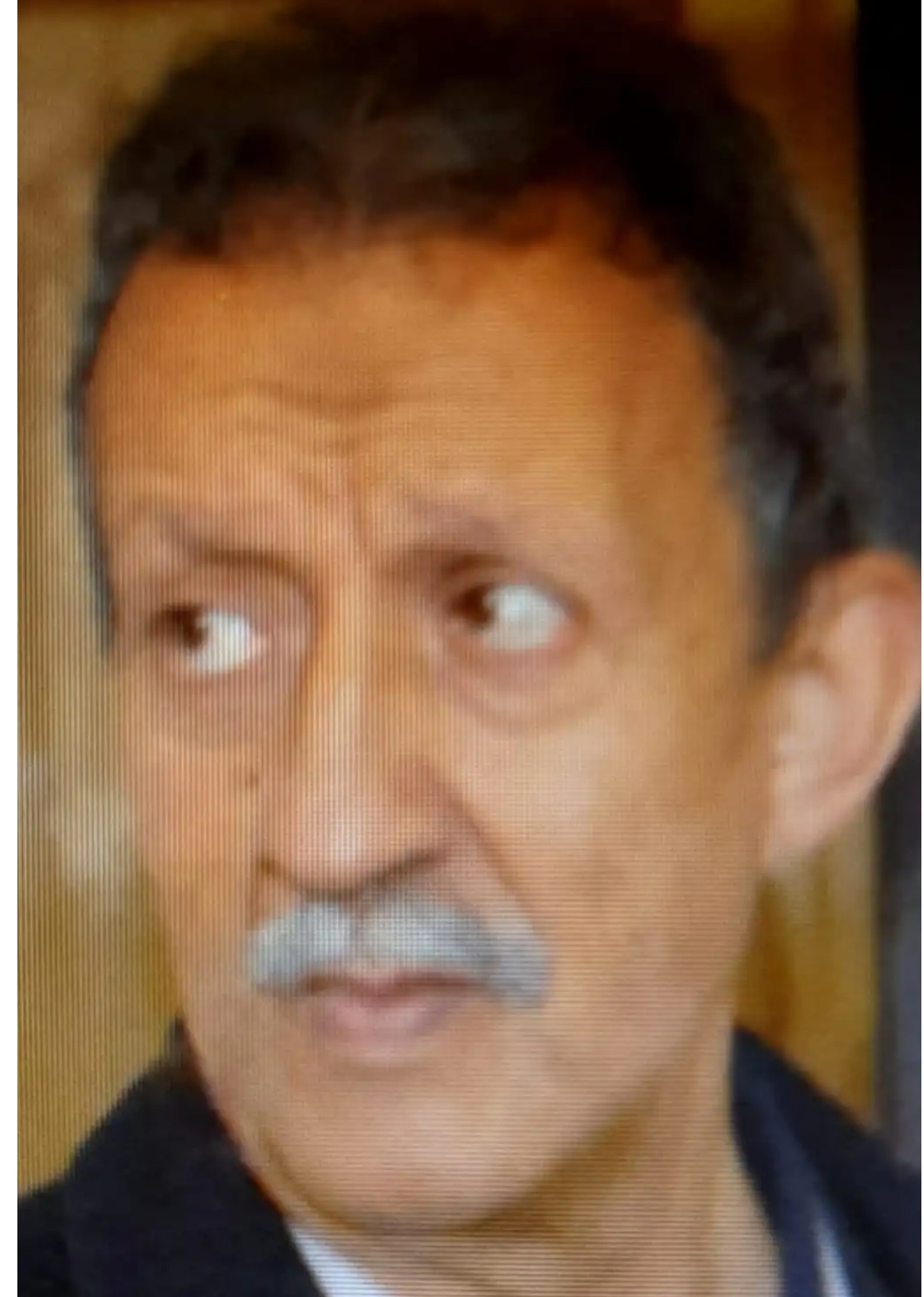


تعليقات 0