ما سرّ هذا التدافع الحاد بين “القرآنيين” و”السّنّيين”؟!!

دعونا بدايةً نتفق على تعريف واضح وصريح لكل من “القرآني” و”السّنّيّ”، كما يدل على ذلك الاستعمال السائد لهذين الوصفين، بعد التأكيد المُسْبَق بأن في هذا التفريق تشيُّعاً يرفضه التنزيل الحكيم، ويَذُمه ذَمّاً من شأنه أن يُثيرَ الرعب والرهبة في نفس كل مؤمن ومؤمنة!!
بالمناسبة، والمناسبة شرط كما يقول المناطقة، يقول التراثيون إن “القرآنيَّ” شخصٌ يُنكِر السُّنّة قولاً واحداً، وبذلك فهو “يسعى إلى هدم الدين بتنكّره لثلاثة أرباعه المتمثلة في السُّنّة”، ويقصدون بالسُّنّة الحديث حصراً، ثم السيرة، وكلاهما نتاج عمل الرواة، وبالتالي فهما نتاجٌ بشريٌّ تاريخيٌّ وليس وحياً، بمعنى أنه نسبيٌّ، والنسبي قابلٌ بالبداهة للمراجعة والتعديل والتغيير، وللرفض عند الاقتضاء، لأن صفة الثبات تستحيل في حقه إذْ لا ثباتَ أساساً وبدءًا ونهايةً إلا للهِ وكلامِه وأمرِه وحُكمِه، كما بيّنتُ ذلك بوضوحٍ كافٍ في مقال سابق.
غير أن حقيقة “القرآني”، كما يُفهَم من قوله وسلوكه هو ذاته، أنه “لا يُنكِر السُّنّة”، بمعناها الباطل الذي يحصرها في “الحديث والسيرة”، وإنما يلتزم بعرضها على القرآن، فما خالف منها القرآن رفضه وألقاه وراء ظهره بلا أدنى حرج، لأنه يعتبره نصّاً تاريخياً بشرياً، وبالتالي محكوماً ببيئته وظرفه التاريخيَيْن والمجتمعيَيْن حتى لو صدر عن “نبي” مُرسَل، وتلك سنة الله في سائر خَلقه، ولا أقول حتى لو صدر عن “رسول”، لأن المبعوث في مقام الرسالة لديه من العصمة ما يضمن تبليغَه رسالةَ ربه بلا نقص أو زيادة… أما إذا وافقت السُّنّة القرآن فيتعامل معها القرآنيّ من منطلق “الحكمة” الكامنة فيها وليس أكثر، إن كانت بطبيعة الحال مستوفيةً لشروط الحكمة.
ومن المسلّم به أن ما ورد عن النبي الكريم فيه من الحكمة ما لا يستطيع إنكاره إلا جاهل أو معتوه… والإشارة هنا حصرياً إلى ما صدر عنه حقّاً، وليس إلى كل ما نسبه إليه جمهور الرواة، والتنزيلُ الحكيمُ هو الميزانُ العادلُ والمعيارُ الصادقُ والدقيقُ للفصل بين “المَتْنِ” الصحيحِ ونظيرِه الكاذب، وليس “السَّنَدُ” هو المعيار كما أخذ بذلك أهل الحديث!!
أما تعريف “السنّيّ”، فهو كل مسلم يعتبر “السّنّة مكملةً للدين”، ويراها “مصدراً ثانياً من مصادر التشريع الديني”، ويضيف إليها مصادر أخرى كالإجماع والتواتر والقياس… غير أن هذا التعريف يقتضي أن يكونَ الدينُ “غيرَ كامل”، وبتحصيل الحاصل فهذا يُوقِع القائلَ به في ورطة في غاية الخطورة، لأنه يجعله يبحث عن “كمال الدين” خارج الرسالة المُبَشِّرَةِ به، وبالتالي بعيدا عن الدّيّان جل وعلا، الذي قال وقوله الحق: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًاا” (المائدة-3)… فأين يضع السُّنّيُّون هذا القولَ الربّانيَّ المتصفَ بالثبات والإطلاق؟!
الواقع ولعياذ بالله يقول إنهم يكذّبونه!!!
المشكلة الآن ليست في كون القرآني رافضاً للسّنّة، ولا في
كون السنّيّ معتقداً بعدم كمال الرسالة، بل هي كامنة في فكر السنيين واعتقادهم وسلوكهم، لأنهم مصنّفون بالمعيار القرآني “مِنَ المُشْرِكِينَ”، لأنهم “فرّقوا دينهم وصاروا فيه شِيَعاً”، بل فعلوا ذلك أو قَبِلوا به وانتظموا فيه “وهم يتلون الكتاب”، تماما كما فعل بنو إسرائيل من قبلهم، والكتاب يقول بصريح العبارة وواضحها: “… وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ” (الروم- 31 و32)… وكما هو واضح فإنّ حرف “مِنْ”، الدال على “التبعيض” في هذه الآية، مردُّه إلى كون المتشيِّعين في الدين تعتبرهم الآية أعلاه بعضاً من المشركين، كما أنّ “الشرك” صفةٌ “لكل من يفرض اعتقاده على غيره باسم الله ودينه”، وهذا، كما وضّحتُه في مقال سابق، هو التفسير البديهي للأمر الإلهي بمقاتلة “المشركين” و”قتلهم” أينما ثُقِفوا، لأنهم تعدّوا حدود الله وتطاولوا على سُلطة ربّانية لا تحق لغير رب العزة، فصنعوا نمطاً شرعياً يُحِلُّ ويُحَرِّم وألزموا به أنفسهم خارج النمط القرآني، ثم طفقوا يفرضونه على غيرهم باسم الله، وباسم دين الله وشَرْعِه، ويسعَوْن إلى ذلك بكل الوسائل بما فيها الجبرية والعنيفة، وقد سلف القول في عين المقال السابق إن هؤلاء هم “الإرهابيون” في تعريفنا الحديث لذلك المنحى الإقصائي والمتطرف من الفكر والاعتقاد، و من السلوك المسمى اعتباطاً بالديني!!
ها قد وقفنا الآن عند مفارقة في الفكر والفهم والاعتقاد في غاية الخطورة:
– عِباد يعتقدون اعتقاداً راسخاً بأنهم مؤمنون، يعتنقون نمطاً من الفهم والقناعة يشدهم إلى الماضي، في الْتِصاقٍ عضويّ غيرِ مَعقولٍ بالسلف، وبالفكر السلفي، دون أن ينتبهوا في فورة تعصبهم لذلك الموقف أنهم يخالفون سنة الله التي لا تبديل لها في سائر خلقه، وهي سنة التغيّر والتحوّل والتطوّر، فيجعلون فكرَ ومفاهيمَ السلف في مثل “ثبات” كلام الله وأوامره واحكامه المطلقة، القمينة وحدها بأن تكون أزليةً وأبديةً، ثم يُفتون بإقصاء أو تعنيف أو قتل كلِّ مَن لا يعتنق نفس الأفكار والمفاهيم، وبذلك أفتوا بقتل المرتد خارج القرآن، ورجم الزانية والزاني خارج القرآن، وقتل تارك الصلاة بل وقتل الذي يجهر بنية الصلاة خارج النص القرآني كذلك… وقائمة هذه الأفعال الشركية طويلة وحافلة… وبذلك أشّروا من حيث يقصدون أو لا يقصدون على كونهم “إرهابيين”، بالمعنى الاصطلاحي الحداثي للكلمة، وبالتالي “مشركين” بالتوصيف القرآني المعبَّر عنه في الآية أعلاه، لنفهم كما سبق القول، كيف أن رب العزة أمر بمقاتلة المشركين في كل زمان ومكان، وبكل الوسائل… وهذا ما يفعله كل الأمم والشعوب والأنظمة في مشارق الأرض ومغاربها!!
فأي الموقفين أحق بالتفهّم والمُناصرة، موقف القرآنيّ الذي يرفض ما دون القرآن فلا يقبل منه سوى ما وافق هذا الكتاب الحكيم؟
أم موقف مَن يرى الدين “رُبْعاً من القرآن وثلاثةَ أرباع من السُّنّة والروايات الظنية”، مستنداً في طُروحاته إلى منظار السلف، فيسبغ بذلك “صفة الثبات” على ذاتِ المنظار، ثم يعمل بكل الوسائل المتاحة على نشر فكره وفهمه ولو بالقوة والعنف والجَبْر؟!!
الصورة واضحة، والسبب كان وسيظل جليّاً بخصوص هذا التدافع الشرس بين فريقين:
– الأول منهما: يرتاح كل الارتياح لما كان عليه القرآنيون الأوائل، متمثِّلين في الصادق الأمين، وصحابتِه، ثم خلفائه الراشدين من بعده، إلى غاية بدايات عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي ظهرت أولى محاولات تدوين الروايات إبّان خلافته، قبل أن يستفحل ذلك على أيدي رواة وفقهاء بني العباس، ليُنتِج لنا هذا التوجّهُ الشارِدُ ديناً موازياً لا ريب أنه المبرر المنطقي لنزول الآية المستقبلية الواردة على لسان المصطفى: “وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا” (الفرقان- 30)!!
والفريق الثاني: اتخذ مصادر للتشريع الديني غير الله وكلامه الثابت والمطلق، فأسبغ صفة الثبات والإطلاق والبقاء على مصادر بشرية أطلق عليها أسماءً ما أنزل الله بها من سلطان:
* “السّنّة“، بمعنى الروايات الظنية التي أسس لها هذا الفريق “عِلماً” لا يستوفي أيَّ شرط من شروط “العلمية” سمّاه “علم الرجال”، و”علم التجريح”… وأسماء أخرى من ذات القَبيل… بينما السّنّة في التنزيل الحكيم سُنّة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل؛
* “الإجماع“، إشارةً إلى واقع يُشَكِّل حُلماً لم يتحقق أبداً، ولن يتحقق في المستقبل المنظور، لأنه يُفتَرَضُ أن يتم على أيدي “علماء” و”فقهاء” و”شيوخ” و”حُفّاظ” فرّقوا دينهم منذ البداية، ثم تفرّقوا فيه إلى مذاهبَ وطرائِقَ وشِيَعٍ وفروعٍ لا حصر لها؛
* “القياس“: المراد به إلباس قضايا اليوم أرديةَ ومقاييسَ قضايا الماضي البعيد، من أجل فهمها ومعالجتها بما كان السلف يفهمون ويعالجون به قضاياهم، دون أدنى اعتبار لسنة التحوّل والتغيّر والتطوّر؛
* “الأخبار والآثار“: باعتبارها إرثاً “للتابعين ومَن تبعهم بإحسان”، وبقيةً من آثار “السلف الصالح”، الذي ينبغي اعتبارُه من هذا المنظور معصوماً من الخطأ، وهذا محال!!
معذرة، فأحياناً يخيّل لي أنني أجترُّ بين كل مناقشة وأخرى نفس الأفكار، لأنني مضطر إلى استعمال نفس المُسَمَّيات، ربما لأنّ المفارقاتِ موضوعَ هذا النقاش متشابهةٌ ومترابطةٌ ومتعلقةٌ بالهمّ ذاته: “التديّن المنحرف عن أصله وأساسه الأول، الذي يبقى القرآن مصدرَه الفريد”…
إننا قد نتنافسُ على إبداء محبتِنا للرسول الأكرم، الذي بلّغ إلينا ذلك المصدرَ واضحاً مفصّلاً اكتمَلَ به الدينُ وتمت به نعمةُ رب العالمين… غير أنّ الشعور بالمحبة والتعبير عنها شيء، واتخاذها مصدرا للدين وللشريعة شيء آخر مختلف تمام الاختلاف… وهنا مصدر هذا الصداع المزمن الذي يصيبني شخصياً بين كل مقال وآخر…
أسأل الله السدادَ في الفهم والرأي والإفصاح، والسلامةَ في الفكر والحال والمآل!!!
بقلم ذ. عبد الحميد اليوسفي


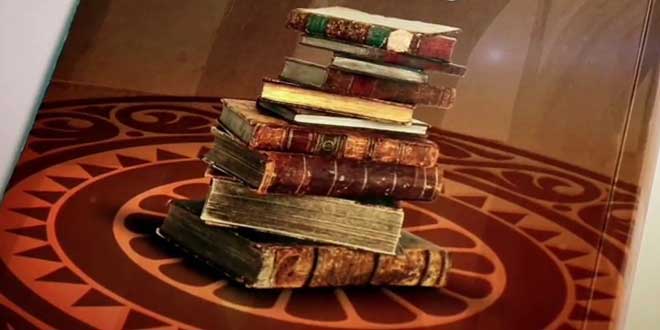


تعليقات 0